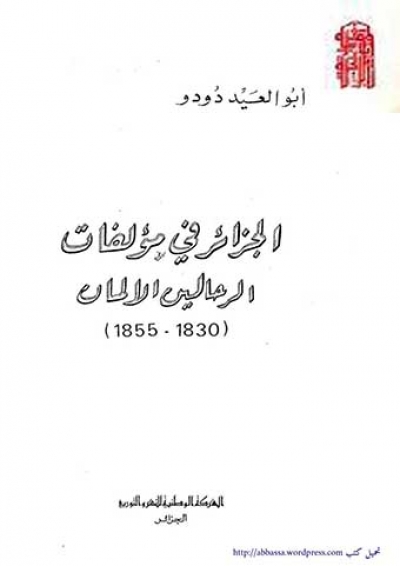عاش في جزائر نهاية العهد التركي وابان الإحتلال الفرنسي، على الخصوص عدد من الأسرى والعبيد كانوا ينتمون إلى معظم شعوب أوروبا. زارها كذلك بعض الرحالين والكتّاب والعلماء والشعراء، وبعد رجوعهم إلى بلدانهم أصدروا كتبا على شكل رحلات أو بصورة رسائل أو مذكرات، تحدّثوا فيها عن تجاربهم الشخصية في الجزائر وعلاقاتهم بأهلها وعبّروا عن موقفهم من قضاياها الدينية والاجتماعية والثقافية والسياسية والخلقية، وتطرّقوا إلى وصف العادات والتقاليد وأساليب الحياة في المدن والقرى والأرياف.
يذكر ابو العيد دودو، في كتابه بعنوان “في مؤلفات الرحالين الألمان 1830-1855”، بعض مؤلفات الرحالة الألمان التي أصدروها لتكون دليلا لمن أراد من مواطنيهم الهجرة إلى الجزائر لإنشاء مستعمرات والإقامة بها إقامة دائمة تحت ظلّ الإحتلال الأجنبي وحماية حكومته، فقد كانت مصالح مواطنيهم مرتبطة بمصالح الغزاة، إضافة إلى أن بلادنا كانت قريبة إليهم من أمريكا أو البرازيل وغيرها من دول العالم الجديد التي كانوا يهاجرون إليها سابقا.
كان أغلبهم يشاركون المحتلين في عواطف الحقد على الدولة الجزائرية، ويرغبون في الإنتقام تحت ستار الدين والتضامن الأوروبي.
اهتم الألمان بداية بترجمة ما كتبه مؤلفون أجانب عن الجزائر، مثل كتاب الرحالة الإنجليزي توماس شو، بعنوان “رحلة في ولاية الجزائر” في 1765، وكتاب الشاعر الإيطالي فيليو بنانتي، بعنوان “رحلة إلى سواحل البرابرة” في 1824، وبعد إحتلال الجزائر بمدة قصيرة نشرت مجلة الكتب السنوية في عدد سبتمبر 1830 دراسة مطولة، استقت الكثير من معلوماتها عن الجزائر من المجلة الإيطالية للعلوم والآداب والفنون، وأضافت مما عثرت عليه في مراجع ومصادر أخرى.
واستعانت أيضا بكل من شو، بنانتي، وبيير دان، الذي صدر كتابه في باريس عام 1649، تحدث مؤلف الدراسة عن ولايات الجزائر، وموانئها وجبالها وانهارها وبحيراتها ومناخها وخصوبة أراضيها ومنتجاتها الزراعية، وأشار إلى أهم المدن وقدّم خلاصة لتاريخها خاصة القل، بجاية، عنابة، جيجل، قسنطينة والجزائر.
ويذكر شو، أن بالجزائر عشرة مساجد كبيرة وحوالي خمسين مسجدا صغيرا وخمس مدارس وعددا كبيرا من مدارس الكتاب، ولعلّ أهم ما ورد في هذه الدراسة هو مسألة العبيد التي اتخذتها أوروبا ذريعة للإعتداء المتكرّر على السواحل الجزائرية.
وتجدر الإشارة إلى أن، هؤلاء العبيد تقلدوا مناصب في الدولة الجزائرية قبل 50 سنة، وكانت أوضاع الأسرى في الجزائر أفضل بكثير من أوضاع أمثالهم في البلدان المسيحية على عكس المغالطات، التي تدعي غير ذلك.
تقلد كثير من عبيد الجزائر وظائف سامية جلبت لهم الخير والنفع والثراء، وهناك من صعب عليه ترك الجزائر والتخلي عن أرضها، وحين غادرها تحسر على النعيم الذي كان فيه، ويتحدث المؤلف عن امرأة سويدية عاشت معززة مكرمة في الجزائر، انتقلت الى إسطنبول قبل الإحتلال بمدة قليلة، وتحدثت مع بعض الأوروبيين عن أوضاع العبيد في الجزائر.
وتذكر المجلة في نهاية دراستها أن الجزائريين لا ينقصهم الذكاء والمواهب والقدرة على التطوّر، لكن الإظطهاد التركي هو الذي تركهم على هذه الحالة وقد بدأ اتصالهم بأوروبا قبل نصف قرن إذ سافر إليها كثير منهم، وزاروا بعض بلدانهم وحصلوا على معارف متنوعة أدت إلى ظهور مواهبهم المختلفة.
ويؤكد دودو، أن الرحالة والعالم فيلهلم شيمبر 1804-1878، انساني وموضوعي فهو أخو العالم النباتي المشهور كارل فريدريش، زار شيمبر الجزائر في ديسمبر 1831، وأقام بها حوالي عشرة أشهر، وبعد عودته إلى بلاده بسبب إصابته بالحمى المتقطعة افقدته ذاكرته لفترة قصيرة، أصدر كتابا صغير الحجم بعنوان “رحلة فيلهلم شيمبر إلى الجزائر سنتي 1831و1831، طبع بمدينة شتوتغارت عام 1834.
وعند وصوله إلى ميناء الجزائر كان أول ما لاحظه هو الأخوة في سلوك الحمالين مع بعضهم البعض، لما اختار حمالين قدم لهما الآخرون أدوات الحمل من حبال وعصي وابتعدوا بكل هدوء، فحمله هذا السلوك على المقارنة بينهم وبين الحمالين في أوروبا وقال عنهم أن لهم عكس ما للجزائريين من خصال حميدة ووصف الأوروبيين بالقبح والغدر والكسل.
لم أعثر على جزائري جاهل القراءة والكتابة
ويقول: “بحثت قصدا عن عربي واحد في الجزائر يجهل القراءة والكتابة، غير أني لم أعثر عليه في حين وجدت ذلك في بلدان جنوب أوروبا، فقلّما يصادف المرء هناك من يستطيع القراءة من بين أفراد الشعب، ومن الإنصاف أن نقول إن الجزائريين يتكلمون الفرنسية بطلاقة، وذلك ما دعا الحكومة الفرنسية إلى استخدامهم في الوظائف العمومية، والفرنسيون الذين يتكلمون العربية لا وجود لهم إلا في النادر جدا”.
ويؤكد المؤلف أن الحضر ملمون بالعلوم، ولكنهم لا يهتمون بها، فإذا حفظ أحدهم القرآن وتعلم الكتابة وأصبح في مقدوره تفسير القرآن فإنه يعد عالما كبيرا، وإذا أدى فريضة الحج فإنه يعتبر نفسه مرابطا، يتسم سلوكه بالإنعزال والإنصراف عن الدنيا، وله ما يقوم على خدمته، إلا أنه في كثير من الأحيان يؤدي بنفسه كثيرا من الأعمال المختلفة.
وعن المساجد ويقول: “إن أروع مسجد في الجزائر هُدّم لتقام مكانه ساحة للإجتماعات، مع أنه كان في الإمكان إقامة هذه الساحة قرب مقام الحاكم الفرنسي، وأصبح كثير من المساجد مخازن للتبن بينما تحوّل البعض إلى بنايات عسكرية، وهناك مسجدا أعطي لبعض السادة الحلوين لمزاولة العزف على الكمان، وهُدّمت أضرحة عزيزة على قلوب الجزائريين ليقام مكانها ميدان للتدريبات المختلفة”.
ويدعو شيمبر، في كتابه إلى إحترام قوانين الجزائريين ومعتقداتهم ليتمكّن الأوروبيون من كسب ثقتهم والميل إليهم.
ويتحدّث المؤلف عن الحمامات في الجزائر، وعن الدور الذي ينسبه إليها الحضر في معالجة الكثير من الأمراض أو الحيلولة دون وقوعها، ويتحدّث عن طريقة من طرق العلاج التي شاهدها في الحمام ويصفها على الصورة التالية: “دخل إلى الحمام شاب انتفخت لوزتاه عند فكه الأسفل، واستحم ثم اتجه إلى رجل كبير السن كان جالسا في الرواق، ومع أنه لم يكن طبيبا فقد اضطجع الشاب أمامه، فوضع يديه فوق لوزتيه وضغط عليهما بشدة رافعا إياه عن الأرض لمدة طويلة، ثم أعاده إلى مكانه، قد أعوج وجه الشاب الذي فتح عينيه برهة ثم اغمضهما وقد بدا عليه أنه فقد وعيه تماما، وعندما استيقظ ثانية ونظر حوله مستغربا.. كرّر الشيخ العملية معه مرة ثانية وثالثة إلى أن غاب الشاب عما حوله مدة طويلة، وبالتالي فتح عينيه وتنفس بقوة واستحم من جديد، ثم غادر الحمام وقد شفي من مرضه”.
ويؤكد شيمبر، ما قاله بفايفر قبله، من أن الطب يكاد يكون غير معروف في الجزائر، فلا يوجد في المدينة على كبرها سوى طبيب عربي واحد وهو صيدلي في الوقت نفسه ويصف هذا الطبيب بالجهل والكسل فعلى الرغم من دراسته الطب في مدينة ليفورنو، لمدة لم يستطع تحديدها، فإنه لم يكن يعرف كلمة إيطالية واحدة ولا إسبانية، بل لا يعرف حتى اللغة الفرنجية التي يتكلمها كل إنسان في الجزائر.
يقول: “أسعد أوقات هذا الطبيب هي تلك اللحظات التي لا يطلب منه فيها القيام بعمل ما”.
ويتحدّث المؤلف عن السلوك الإنساني والمعاملة الطيبة للجزائريين مع الأشخاص الذين فقدوا بصرهم، فقد رآهم يشفقون عليهم ويساعدونهم، على عكس الأوروبيين الذين يعاملونهم معاملة في منتهى القسوة.
وقال: “كانت الشحاذة مقصورة عليهم، والأصحاء فكان من العار عليهم في نظر الجميع أن يمدوا أيديهم تسولا”.
محلات نظيفة
ويؤكد شيمبر، أن محلات الأوروبيين قذرة بصورة تشمئز لها النفس، في حين محلات العرب نظيفة ومنسقة تنسيقا حسنا تكشف عن ذوق رفيع وأصالة تامة، ويقول إنه بإمكان الإسكافي الأوروبي الذهاب إلى الجزائر ليتعلّم كيف تصنع الأحذية.
ويتأسف المؤلف للمعاملة السيئة، التي يتعرض لها السكان الأصليون من طرف السفلة الذين وصلوا إلى الجزائر من كل أنحاء أوروبا ووجدوا فيها ملجأ ومقاما، ويتحدث عن وحشية الغزاة الفرنسيين في إبادة إحدى القبائل الجزائرية وهي قبيلة العوفية، وهو متأكد من صحة الحادثة لأنه اتصل بعدد من الجنود الذين شاركوا فيها فوجد البعض منهم يتحدّث عنها باشمئزاز ويشكو من أن السلطات لم تضع حدا لمثل هذه العمليات الإجرامية، والبعض الآخر يتحدث عنها بفخر.
ويضيف: “لقد حدثني أحد السفاحين في كبرياء وقال: “كان هناك طفل واقفا في مؤخرة الخيمة، فصحت به أخرج يا حقير وإلا فسوف أطلق رصاصة في فمك ولكن البهيمة لم يطعن وعندما ضغطت على الزناد طار نصف رأسه وتعلق بكتان الخيمة”.
ويعلق على رواية الجندي القاتل: “.. هذه هي أعمال العسكريين الذين يشغلون وظائف في السجون ويجلسون فوق منصات المحاكم”.
ويروي المؤلف أنه كثيرا ما كان يخرج إلى مناطق الحراسة فيشاهد الفرق الكاملة من الجنود الفرنسيين وبعض الجزائريين المنضمين إلى الفرقة الأجنبية يتربصون بالعرب العائدين من الأسواق ليسلبوهم ما معهم من مال ومتاع، وكانوا مجردين من السلاح، ولكنهم كانوا يسيرون جماعات لهذا الغرض، ويذكر أنه كان مرة عائدا من بعض جولاته، فانضم إليه في أثناء الطريق باريسي وعرض عليه أن يقتل له جزائريا نظير خمسة من الفرنكات.
الإسبان يبيعون الورود والعرب الطيور والحيوانات البرية
ويصف موريتس فاغنر، عالم طبيعي ورحال ألماني 1813 - 1887، ميناء الجزائر، ويتحدث عن العاصفة التي حطمت قبل ثلاثين سنة سفينة، ويذكر أن وصول السفن إلى ميناء الجزائر يعتبر عيدا بالنسبة لأهل البلاد، فهم يكسبون في اليوم الواحد ما يكفيهم لأيام، وذلك أن ما بين الإسبان وبينهم عداوة أجبرهم على تقاسم العمل معهم والإشتغال يوما دون آخر، وكانت الباخرة لا تصل الجزائر إلا مرة في الأسبوع، ويتكوّن العمال الجزائريون من العرب، الزنوج والبسكريين.
ويشير إلى أن الثياب الرثة ليست دائما ثياب الدراويش، والطعام القليل ليس دليلا على الفقر والعوز، فهناك من البسكريين من يحمل تحت ثيابه خمسين دولارا إسبانيا ويشد عليها مثلما يشد على أمعائه، ومع هذا فإن روائح المطاعم الفرنسية الطيبة لا تثير شهيته بأي حال من الأحوال، وإنما يكتفي بالخبز الردئ يأكله مع التين أو التفاح ويتناول طعامه في قاعة أكله تحت النجوم الجميلة.
ويصف الأشياء التي كانت تعرض في السوق بساحة الحكومة ويقول إن هناك من المبيعات ما هو مقصور على البعض دون الآخر، فالإسبان يبيعون الورود والأزهار والمالطيون الأسماك والخضر والبرتغال والعرب الطيور والحيوانات البرية، وكانت الأرقام مكتوبة بالفرنجية، وكان النطق بها أقرب إلى الإسبانية منه إلى الإيطالية.
وتحدّث عن حيوانات غريبة شاهدها تباع في السوق، ويذكر أن كلمة الجزائر تعني الغازية وهذا الاسم يوحي بالبطولة والقوة، وحين يسأل أهل البلاد لماذا دعيت الجزائر بالغازية، يجيبون “لأنها أخضعت المسيحيين” ويحدّد سكانها بـ28 ألف باستثناء الجيش الفرنسي، 9 آلاف من حضر، 6 آلاف من اليهود، و5 آلاف أجناس مختلفة و8 آلاف من الأوروبيين وهذا منتصف سنة 1839، لكنه يعترف بأن هذه الإحصائيات غير دقيقة.
يصف شوارع الجزائر ويذكر أن المكتبة تحتوي على حوالي 600 كتاب منها كتاب معروف عن مصر ومخطوطات عربية أخرى نفيسة استولى عليها الفرنسيون في دار ابن عيسى بقسنطينة، ومساجد أخرى من المدينة نفسها.
ويؤكد فاغنر ما ذكره شيمبر، أن الحكومة الفرنسية هدّمت الكثير من المساجد لتوسيع الشوارع أو إقامة بنايات جديدة، وقد لقي المسجد الذي كان قديما يحتل مكان السوق المصير نفسه، وكان أفخر جامع بالجزائر، وهناك مساجد فقدت وظيفتها القديمة.
ويعلق فاغنر “هكذا اعتدت فرنسا على حرمات المسلمين، وذلك ما لن يغفره لها الجزائريون ولن ينسوه أبدا”، ويشير إلى أن عدد المدارس قبل دخول الفرنسيين بلغ حوالي 100 مدرسة ولم يبق منها سوى النصف تقريبا ويذكر مواد الدراسة ويصف علاقة الأستاذ بطلابه والثقة التي تسود هذه العلاقة وبقائها حتى بعد انتهاء الطالب من دراسته.
وينتقل للحديث عن المحكمة العليا، التي تتألف من خمسة قضاة من بينهم يهودي ومسلم ثم صار عددهم لا يتجاوز اثنين يضاف إليهما رئيس له صوت واحد، وكان القاضي هو الذي يفصل بين الأهالي وكانت المرافعات تستمر أحيانا حتى ساعة متأخرة من الليل ولم تكن تخلو من مهازل بسبب الخطأ في الترجمة، والمحكمة العسكرية تقع قرب باب عزون تجتمع باستمرار للنظر في الجرائم، التي يرتكبها جنود الجيش الإفريقي وتتمثل في بيع الأسلحة والذخيرة، وأحكام الإعدام لم تكن قليلة وخصوصا أيام روفيقو، حتى كان الإعدام ينفذ كل أسبوع.
ويتحدث عن محكمة القاضي المالكي والحنفي قرب باب الواد ويذكر أن منصب القاضي كان يشغله سنتي 1837 - 1838 سيدي أحمد بن جدو.
وأسواق الجزائر في نظر المؤلف لا تشبه لا أسواق بغداد ولا أسواق مدينة القسطنطينية، قضى الفرنسيون على الأسواق الجميلة وأقاموا مكانها دكاكين ومخازن أوروبية، ومحلات العرب صغيرة جدا وأغلب أصحابها من الكراغلة، وتباع فيها البلغ ومحافظ النقود وغير ذلك وتتكون البضائع على الأكثر من العطور مثل الورد والياسمين والمصنوعات الحريرية وهي جميلة إلى حدّ بعيد على الرغم من أنها مصنوعة يدويا.
يوجد في الحي العربي حوالي 60 مقهى يتعلم الأجنبي فيها مختلف المصطلحات الجزائرية، وأحسن مقهى عربي يكثر فيه الرواد يقع في شارع الديوان، ويزوره عدد كبير في القديم موسيقار الداي الخاص، يمتاز بالمهارة في العزف وفي بعض الأحيان تظهر في المقهى نفسه فتيات يرقصن ويغنين.
والمقاهي في القسم الأعلى من المدينة المشاهد فيها أكثر أصالة ففيه يوجد المقهى اليوناني، تجتمع فيه حثالات البشر من كل جنس من غير تمييز عنصري أو ديني فكان فيه المسلم، المسيحي واليهودي والأوروبي والإفريقي، تختلط أصوات السكارى رجالا ونساء بأصوات الآلات الموسيقية.
ويشير فاغنر، إلى أن هناك حفلات خاصة تقام في أوقات معينة ففي أيام رمضان مثلا تقام حفلات القرقوز، يحضرها العرب والأوروبيون.
ويرى المؤلف أن دناءة الفرنسيين تجلت بوضوح في فتح القبور والأضرحة الجميلة بحثا عن الأموال ونقل حجارتها إلى أمكنة أخرى، وأفظع من هذا أن الفرنسيين أخذوا عظام الموتى وحملوها بالسفن إلى فرنسا لبيعها لمعامل مسحوق العظام ومسؤولية هذه الأعمال البغيضة تقع على عاتق روفيقو، فقد دفعه حقده على المسلمين إلى جرح مشاعرهم الدينية.