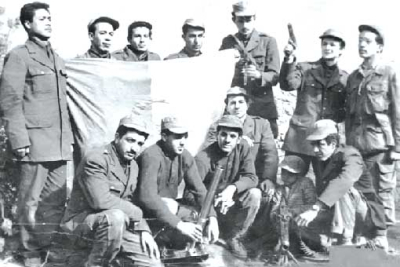المستعمــر القديـم لــم يفهـم بعــد معنى الندّيــة والسيـادة
مع حلول اليوم الوطني للمجاهد تعود الذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955 ومؤتمر الصومام 20 أوت 1956 لتضع الأزمة الدبلوماسية الراهنة بين الجزائر وفرنسا في إطارها الصحيح، إذ لا تبدو الخلافات الحالية مجرد سجال بروتوكولي بسيط، بل اختبارًا متكررًا لمعنى الندية والسيادة في إدارة العلاقات.
تكشف اللحظة أن ما ترسخ في التاريخ الجزائري من توازن بين المبادرة الشعبية والهندسة المؤسسية ما يزال يوجّه طريقة قراءة الحاضر، فحين تُعامَل الملفات الحساسة بمنطق الإشارة والضغط الرمزي تتولد استجابات متقابلة تعيد تعريف قواعد التعامل وتؤكد أن التعاون لا يقوم من دون احترام واضح للقرار الوطني، وكذلك تُظهر الوقائع أن تحويل الهجرة والجالية الجزائرية في فرنسا إلى عناوين تعبئة داخلية لا يصنع سياسة خارجية متوازنة بل يضعف قنوات الثقة التي بُنيت عبر عقود من التبادل العلمي والثقافي والاقتصادي.
الأزمـــة في مـــرآة 20 أوت
جوهر الأزمة الراهنة يتجسّد في محاولات ربط ملفات التأشيرات والتحركات الدبلوماسية بمقاربة “حازمة” تَعدُ بحلول سريعة لمعضلات أعمق، بينما تَقرأ الجزائر هذه الرسائل بوصفها خروجًا عن قاعدة الندية وترد بمقتضى المبدأ نفسه، وفي سياق متصل لا تنفصل هذه المقاربة عن مناخ سياسي فرنسي تتقدم فيه مقولات التيار الشعبوي الذي يجعل من المهاجر والجالية محورًا للشرح السهل لأزمات بنيوية في التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على ذلك تُظهر التجربة العملية أن تسييس الإجراءات التقنية يسرّع اهتزاز الثقة ويحوّل أدوات الإدارة القنصلية إلى إشارات استعراضية لا تنتج تفاهمات مستقرة، وبالإضافة إلى ما سبق فإن منسوب التوتر ينعكس مباشرة على مسارات الطلبة والباحثين وروابط الأعمال الصغرى والمتوسطة وشبكات الثقافة التي لطالما مثلت صمام أمان حين ترتفع حرارة الخلافات.
على هذه الأرضية يصبح استدعاء درس 20 أوت ضرورة تحليلية لا ترفًا خطابيا، فهجومات الشمال القسنطيني لم تكن انفجارًا عفويًا للعنف بل مبادرة استراتيجية كسرت وهم السيطرة بالقوة وحدها ووسعت رقعة الفعل الثوري وربطته بعمقه الاجتماعي، وفي السياق نفسه أفضت ردود الفعل الاستعمارية العنيفة إلى تعرية حدود المقاربة الأمنية البحتة وإبراز أن المسألة سياسية في جوهرها، كذلك جاء مؤتمر الصومام ليحوّل المبادرة إلى هندسة انتصار حين قعّد لأولوية السياسي على العسكري ووحّد البنية التنظيمية وحدد العلاقة بين الداخل والخارج ومنح الثورة واجهةً تفاوضيةً قادرة على صناعة قواعد اشتباك واضحة، وبعبارة مكثفة فقد صاغت ذكرى 20 أوت معيارًا دائمًا، السياسة تضبط القوة والمؤسسية تصون القرار، ومن ثم لا تُدار الأزمات بالرموز العابرة ولا بالخطوات الأحادية.
انطلاقًا من هذا المعيار يمكن فهم ما يجري اليوم، فالجزائر تؤكد أن أي تعاون يتطلب اتفاقات مكتوبة ذات آجال وآليات تنفيذ واضحة وأن الملفات العالقة من الذاكرة إلى التنقل الإنساني ومن التموضع الإقليمي إلى قنوات الاعتماد الدبلوماسي لا تُحل بالإملاء بل بالتفاوض النديّ.
وفي سياق متصل يظهر قصور المقاربة التي تعطي الأولوية لـ«الصرامة” اللفظية داخل فرنسا لأنها تعيد إنتاج سوء تقديرٍ قديم مفاده أن الضغط الإداري قادر على تغيير سلوك دولة تحمل ذاكرة تحرير وتملك رصيدًا مؤسسيًا يعي معنى السيادة، كذلك فإن تحويل الجالية الجزائرية إلى ورقة اختبار ولاء يخلق مواطنة درجات ويهزّ الاندماج من دون أن يقدّم علاجًا لأزمات الإنتاجية والخدمات العامة والطاقات الشابة التي تتطلب سياسات اقتصادية واقعية لا عناوين إقصائية.
وفي ضوء هذا الربط بين الماضي والحاضر تتضح خريطة الخروج من الحافة، فالمطلوب أولًا تحييد القنوات الإنسانية التي أثبتت نجاعتها مثل الجامعات ومراكز البحث وبرامج التبادل والثقافة، وثانيًا العودة إلى طاولة تفاهمات مجزأة إلى رزم محددة، رزمة للذاكرة والاعتراف بالجرائم والماضي الاستعماري وآلياتها العملية، ورزمة للتنقل والهجرة توازن بين متطلبات السيادة والحقوق وإجراءات الإبعاد القانونية، ورزمة للتموضع الإقليمي تراعي حساسيات الأمن القومي، وثالثًا الالتزام بقاعدة “لا مفاجآت” التي تمنع القرارات الأحادية في الملفات الحساسة وتنص على آليات إنذار مسبق وتقييم مشترك.
وفي السياق نفسه تحتاج باريس إلى فصل خطاب الحملات عن مسارات الدبلوماسية الرسمية لأن ربط السياسة الخارجية بمواسم داخلية متقلبة يضع أي اتفاق تحت رحمة الاستقطاب ويقوّض قابلية الاستمرار.
وتؤكد التجربة الجزائرية أن “مدرسة 20 أوت” ليست أرشيفا بل أسلوب حكم، مبادرةٌ محسوبة وسياسةٌ تنظّم القوة ومؤسساتٌ تُنتج القرار ثم تحميه، وبالإضافة إلى ذلك فإن الإحالة السنوية إلى هذه الذكرى لا تستهدف تمجيد الماضي بل استخدامه معيارًا عمليًا للحاضر.
إذ تُذكّر بأن الدولة التي بنت شرعيتها على توازنٍ دقيق بين الفعل الشعبي والهندسة المؤسسية لا يمكن أن تتنازل عن شرط الندية في أي علاقة ثنائية ولا أن تقبل بتسييس ملفات الجالية على حساب الحقوق والقانون، كما تُذكّر الطرف المقابل بأن احترام السيادة ليس عائقًا أمام التعاون بل شرطه المؤسس وأن الاستقرار المتبادل يتطلب نصوصًا قابلة للقياس والتنفيذ لا إشارات تُستهلك في الداخل.
وخلاصة الأمر أن الأزمة الراهنة قابلة للتفكيك إذا عادت إدارة الملف إلى منطق السياسة الذي صاغته ذكرى 20 أوت، سياسةٌ تجعل الاعتراف قاعدة والمصالح المتبادلة معيارًا والاتفاقات المكتوبة أداةً، وفي سياق متصل لا يكفي تغيير النبرة ما لم يتغير المنهج، فمن يقرأ التاريخ يختصر الطريق إلى حلٍّ متوازنٍ ومستدام، أما من يكرر رهانات الضغط والرمزية فسيرى النتائج نفسها تتكرر لأن درس 20 أوت بسيطٌ ومُكلف لمن يتجاهله: لا قوة تَصرف السياسة ولا سياسة تُدار بلا مؤسسات، والندية ليست مطلبًا تفاوضيًا عابرًا بل ضابطًا ثابتًا لاستقرار العلاقة.