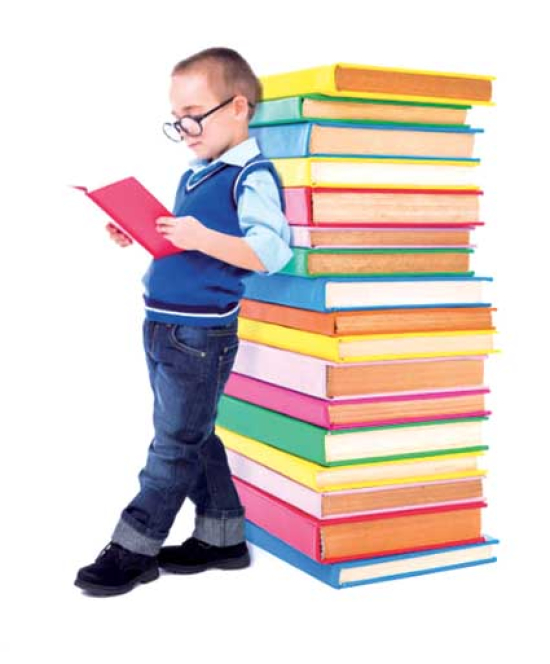ترجمة أدب الطفل مجال بالغ الأهمية، تتقاطع فيها أبعاد تربوية وثقافية ونفسية، وتجمع بين خصوصية المتلقي وحساسية المحتوى، ما يتطلّب مترجما مبدعا يوازن بين الخصائص الثقافية للنص الأصلي ومواءمته لثقافة الطفل المستقبِل. وفيما يعكس تفاوت نسب الترجمة سياسات ثقافية متباينة عالميا، يحذّر أكاديميّون من غزو ثقافي يلبس لبوس التنوع الثقافي، ما يستدعي استراتيجيات توطين واعية تحفظ اللغة والهوية، وتُنمّي ذائقة الطفل الأدبية.
شهر ماي من العام الماضي 2024، نظّم المجلس الأعلى للغة العربية الملتقى الوطني “ترجمة أدب الطفل وبرامجه، بين التنوع الثقافي والغزو الثقافي”، نُشرت أعماله في كتاب أصدره المجلس في العام نفسه.
وفي كلمته بالمناسبة، اعتبر البروفيسور صالح بلعيد، رئيس المجلس، أنّ أدب الطفل “يمتاز بخصائص لا توجد في الأدب العادي، باعتباره يحمل رسالة تكوين الصغار الذين يصبحون كباراً، وعلى عاتقهم أمانة الجيل القادم”.
وهذا الأدب، أضاف بلعيد، يغذي تفكير الأطفال، ويقوّي لديهم الخيال والإبداع والحوار والتفكير الناقد، ويعمل على ترشيد حاجاتهم بما يربطهم بتراثهم وأصالتهم، وما يؤسّس لرؤاهم المستقبلية بالتعليم والتثقيف والتسلية، وتنمية المشاعر الوطنية الصادقة، بغية تحقيق التوازن النفسي.
ووفقا لبلعيد، فإنّ ثقافة احترام الآخر والتنوع الثقافي تبنى من القاعدة، وهنا تبرز أهمية أدب الطفل بمختلف أشكاله، “ليعيش الطّفل في الحمام اللغوي المتفتح على أدب الطفل المترجم، وغير المترجم، منذ الصغر، لأن الطفل متلق ناجح يحب الحركة والديناميكية والعجائبية”.
وذكّر بلعيد بترجماتٍ نالت الصدى، درسناها في المدرسة الجزائرية، وكانت أغلب تلك الإبداعات المترجمة “ذكية في توصيل الأفكار بالتلخيص والبساطة، وإضفاء التشويق والفرجة، بما سلكته من طريقة الرواية على ألسنة الحيوانات أو الطيور، كما تميزت باستهداف سيكولوجية الطفل ككيان مستقل، يحتاج إلى دفعة قوية، سواء ما تعلق منه بالإبداع الأدبي أم الإخراج الفني أم التجسيد الدرامي للنصوص” التي كانت “لا تقل أهمية عن أدب الكبار، بل قد تفوقه لما لهذه الفئة العمرية من خيال متجدد يحتاج فقط إلى ترشيد”.
مقاربات نظرية
تُعتبر ترجمة أدب الأطفال مجالا بحثيا متداخلا يجمع بين دراسات الترجمة، النقد الأدبي، وعلوم الطفولة، وقد تطورت فيه عدة نظريات تفسر وتوجه عملية الترجمة بشكل خاص يتناسب مع خصوصية الجمهور المستهدف من الأطفال.
ومن أبرز هذه النظريات “نظرية التكييف الثقافي”، التي تؤكد على ضرورة تعديل النصوص المترجمة لتتلاءم مع السياق الثقافي للأطفال في المجتمع المستقبل، مع الحفاظ على جوهر النص الأصلي. وأبرزت النظرية أهمية الموازنة بين الدقة في الترجمة والمرونة الثقافية لتجنب “صدمة الثقافة”، فالترجمة الحرفية قد لا تكون فعالة في نقل معنى النص لأطفال ينتمون لثقافة مختلفة، ما يستلزم تكييف النص مع ممارسات وعادات الطفل في الثقافة المستقبلة.
من جهتها، تسلّط “نظرية استقبال القارئ” الضوء على العلاقة التفاعلية بين النص والقارئ، وكيف يقوم القارئ، في هذه الحالة الطفل، بتفسير النصوص المترجمة بناءً على خلفيته الثقافية وخبراته الشخصية.
فيما تركّزت دراسات أخرى على مفهوم إعادة السرد وإعادة البناء في ترجمة أدب الأطفال، فالمترجم لا يكتفي بنقل النص فقط، بل يصبح بمثابة “مبدع” يعيد سرد القصة بما يتناسب مع الفئة العمرية والثقافية للأطفال المستهدفين، مما قد يتطلب تغييرات في الأسلوب أو حتى الأحداث.
نظرة على العالم
أوصت منظمات دولية وإقليمية بترجمة أدب الطفل، نذكر منها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو”، التي تُوصي بإنشاء قواعد بيانات تضم أعمال أدب الأطفال المترجمة لتعزيز الوصول إليها، وتنظيم ورشات تدريب للمترجمين والناشرين، وتشجيع ترجمة الأعمال الأدبية بين اللهجات العربية المختلفة.
من جهته، يشجّع المجلس الدولي لكتب اليافعين (IBBY) على الترجمة “لتعزيز التفاهم بين الثقافات وتوسيع آفاق الأطفال”، مع “ضرورة الحفاظ على الخصائص الثقافية للنصوص الأصلية عند ترجمتها”، و«التعاون الوثيق بين المؤلفين، الناشرين، والمترجمين لضمان جودة الترجمة وتناسبها مع الجمهور المستهدف”.
كما نشير إلى “جائزة ميلدريد ل . باتشيلدر” السنوية، التي تمنحها “جمعية خدمات المكتبات للأطفال في الولايات المتحدة” لأفضل كتاب أطفال مترجم إلى الإنجليزية.
مع ذلك، فإنّ نسب ترجمة هذا الأدب تختلف من دولة إلى أخرى، مثلا، نجد كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة من أقل الدول في نسبة ترجمة أدب الأطفال (في 2021، أقل من 2 % من إجمالي الكتب المنشورة للأطفال في الولايات المتحدة، وأقل من 4 % في المملكة المتحدة)، فيما تتميز الدول الإسكندنافية بارتفاع نسبة الترجمات، حيث تشكل في فنلندا 64 % من أدب الأطفال (سنة 2020)، وفي السويد 45 % (سنة 2020).
وتبلغ النسبة حوالي 33 % في هولندا وفلامس (سنة 2020)، أما في بولندا، فتشكل الترجمات 33 % من إجمالي الكتب المنشورة للأطفال (سنة 2023)، مع تركيز على الترجمة من اللغة الإنجليزية.
من جهتها، تعد الصين من أكبر مستوردي الكتب الأجنبية، حيث تمثل الترجمات 21.68 % من إجمالي الكتب المنشورة، مع تركيز على أدب الأطفال (سنة 2019).
والملاحظ أن الدول ذات اللغات العالمية مثل الإنجليزية تميل إلى إنتاج أدب أطفال محلي أكثر، مما يقلل من الحاجة للترجمات. بالمقابل، تعتمد الدول ذات اللغات الأقل انتشارًا بشكل أكبر على الترجمات لتوسيع قاعدة أدب الأطفال المحلي. مثلا، في الدول الإسكندنافية، يُعد الطفل القارئ جزءًا من سياسات الدولة الثقافية، مما يشجع على إدخال الترجمات في المقررات الدراسية.
عموما، تعكس هذه الفروق التوجهات الثقافية والاقتصادية والسياسية لكل بلد تجاه أدب الأطفال المترجم، كما أن بعض الأعمال المترجمة نجحت في تجاوز الحواجز اللغوية والثقافية لتصبح جزءًا من الذاكرة الأدبية العالمية للأطفال.
بين التّنوّع والغزو.. في ساحة الثّقافة
كما افتتحنا مقالنا بالبروفيسور بلعيد، فإنّنا نختتمه به، خاصة حين التطرق إلى ترجمة أدب الطفل في الجزائر. لقد دعا بلعيد إلى “الحذر من التداخل بين التنوع الثقافي وهو مطلوب، وبين الغزو الثقافي وهو مرفوض”، وأكّد على ضرورة توازن أدب الطفل المترجم “بين الاستفادة من الآخر في لغته، والاحتفاظ بلغتي في إطار الندية، وعدم الترويج لكل أدب يعمل على الاستلاب الثقافي بدعوى العالمية أو العولمة أو بالتهديد الثقافي من خلال الغزو الثقافي وهو خطير جداً يفقدك سلامة لغتك وثقافتك، ويعطل أسلوب التنمية، ويتركك تابعاً إمعة لا تجال لتفكيرك إلا في ما يملى عليك وكفى”.
واعتبر أنّ “الثقافة الغازية” تحتاج إلى مترجمين بارعين وهم يترجمون أدب الطفل بحسن التصرف في تلك المصطلحات التي تخلق السلبية والوهن والفشل وتفقدك الاستقلالية في القرار. وأضاف: “نسعى إلى تنوع ثقافي، وهذه سنة الحياة، ولكن من باب الندية والاحترام المتبادل”، وتساءل إن كان المختصون التراجمة واعين بمهمتهم في نقل أدب الطفل العالمي الذي يعطي القوة والتأثير للآخر، ويلغي فينا كل جوانب الإبداع من خلال موروثنا القديم والحديث؟ والأحرى أن ينال موقعاً في خريطة الوجود، وتقبل أفكارنا في إطار التنوع الثقافي الذي يقبل الاستفادة والإفادة دون التركيز على الواردات الثقافية الأجنبية مهما كان شكلها.
واقترح بلعيد ما أسماه “وصفة بناء استراتيجية ترجمة أدب الطفل بمقتضيات التوطين”، داعيا إلى الابتعاد عن الغربة في كل شيء إلا لدواع خيالية يقتضيها أدب لغة الأصل، وتفادي الترجمة الحرفية بما لا يُحقق الخصوصية اللغوية في اللغة الأم، وبما يناسب قاموس الطفل اللغوي، والعمل دائماً على توطين مجموعة من الأساليب التي هي من صميم لغة الهدف، ولو بإضافة التفسير أو المقابلة، والاحتفاظ بالعنصر الثقافي في النص الأصلي، ومعناه القريب في النص المترجم إليه، مع التبسيط في استبدال مقابل تقريبي في ثقافة اللغة الهدف، وتكييف المقاطع اللفظية الخصائص اللغة المستهدفة لإزالة الغربة اللغوية، وغرس منطق المشترك اللغوي في تدريس أدب الطفل المستهدف.