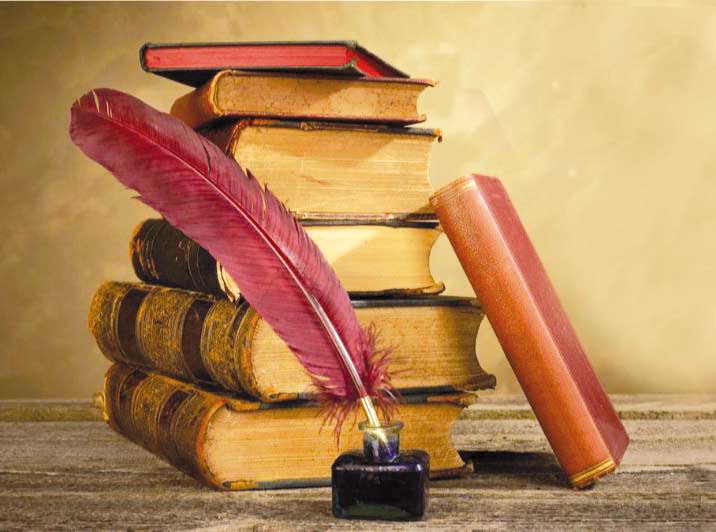الدّراسة الأدبية نشاط معرفي مركّب يتجاوز حدود التلقي السّلبي أو الاستهلاك العاطفي للنّصوص؛ فهي تفرض على الدارس امتلاك “موهبة نظرية” فطرية، يتم صقلها بالمران، وتمكنه من سبر أغوار المشكلات المنهجية واستيعاب الطرق العلمية الضرورية للبحث الأدبي الرصين، فهي شرط لإدراك موضوع الأدب في كليته، إذ إن غياب القدرة على فهم الأبعاد النظرية يجعل من الأدوات النقدية “قوالب فارغة” لا محتوى لها، ويحوّل العملية التطبيقية إلى ممارسة آلية قاصرة تعجز عن ملامسة جوهر الفن أو استنطاق مكنوناته العميقة.
عادة ما يخطو الدارس الشاب خطواته الأولى في هذا العالم عبر بوّابة “الحماسة” الجارفة، وهي حالة من الاستلاب الوجداني والانجذاب الفطري نحو الظاهرة الشعرية. ولقد أكّد الواقع غير مرة، أن الحماسة لا تعكس الميل الفني السطحي، لأنّها – في جوهرها – تنم عن “قوة خلق مستترة” تكمن في أعماق الطالب، حيث يتم إيقاظ هذه الطاقة الإبداعية الكامنة من خلال الانخراط في الاهتمام النظري بالشعر، ما يجعل البدايات الأدبية مزيجا بين الشغف العاطفي والرغبة في التقعيد المعرفي، إلاّ أن هذه الحماسة المبكرة سرعان ما تجد نفسها في مواجهة “صدمة المنهج”؛ فكلّما كان تحمس الدارس للشعر أكبر، كانت خيبة أمله في بداية الدراسة الأكاديمية أعمق وأكثر حدة، ويعود ذلك إلى أن الدراسة الأدبية – في مراحلها الأولى – لا تعمل على تعميق التجارب الحسية المباشرة أو تعزيز المتعة الذاتية، بحكم أنها تبدو للدارس وكأنها تقوده بعيدا عن “روح الشعر” وجوهره النابض، حين تستبدل النشوة الجمالية بصرامة التحليل وتقنيات التفكيك التي قد تبدو جافة.
وتتجلّى الخيبة حين يجد الدارس نفسه مضطرا ليترك المتعة بجمال القصيدة، إلى عمليات إحصائية للنبرات والمقاطع، أو التوقف عند كلمات مفردة كانت تبدو سهلة في سياق القراءة العادية، لتغدو بالغة التعقيد عند تتبع استعمالاتها التاريخية في أعمال الشاعر أو معاصريه، وعوضا عن الاستسلام لسحر الدراما المسرحية، يجد الباحث نفسه مرغما على تفكيك أجزائها وشرح مكوناتها البنيوية، إلى حد يخيل إليه فيه أن “الحياة” قد فارقت العمل الأدبي تحت مشط التشريح النقدي، ما يولد اتهاما شائعا بأن علوم الفن تضعف الميل الفني أو تحطمه، غير أن هذا الشعور بالخيبة ليس سوى مرحلة انتقالية ضرورية للوصول إلى “الفهم الموضوعي”؛ فالدراسة لا تهدف إلى تحطيم الذائقة، ولا إلى نبذ متعة القراءة، بحكم أنها ترمي إلى تهذيب الذائقة وترقيتها، فالأمر لا يختلف عن المتخصص في الموسيقى الذي يدرك “النشاز”، ويقدر التوافقات النغمية بوعي يفوق بكثير المستمع العادي الذي يكتفي بالانفعال، والدارس المكون أدبيا يكتسب القدرة على قراءة العمل الشعري بصفته “بناء قيميا” مستقلا، وبذلك، تنتقل الدراسة بالباحث من منطقة “الذاتية المحض” إلى فضاء “فن القراءة الصحيحة”، حيث لا يكون التفسير مجرد صدى لمشاعر القارئ، إنما يكون استنطاقا صحيحا للنص يجعله يتحدث بلسانه الخاص أمام الآخرين.
إحكام حقل الدّراسة
تزداد الإشكالية تعقيدا عندما يتعلق الأمر بموضوع الدراسة الأدبية، عند محاولة رسم حدود دقيقة لماهية “الأدب” وفصله عن سائر النشاطات اللغوية؛ فإذا كان الأدب – بمفهومه العام والشامل – يستوعب كل ما قُيّد لغويا بواسطة الكتابة، فإنّ هذا التعريف الفضفاض يجعله يتقاطع مع علوم وميادين شتى كالقانون والدين والتجارة، ومن هنا، يبرز التحدي المنهجي في ضرورة حصر الدراسة الأدبية المختصة في ميدان أضيق يمتلك “وحدة موضوعية” ووجهة نظر مستقلة، إذ لا يمكن للنصوص القانونية أو الرسائل الإدارية أن تدخل في صلب علم الأدب لمجرد كونها نصوصا مكتوبة، ويجب البحث عن تلك المجموعة الضيقة من النصوص التي تشكل “الأدب الجميل” وتنفصل بجوهرها عن الاستخدامات الوظيفية للغة.
لقد شهد التاريخ الأدبي محاولات حثيثة لضبط هذا الميدان، حيث عمد الفكر النقدي في القرن الثامن عشر إلى وضع حد فاصل وواضح أطلق عليه اسم “فن الشعر”، معتبرا أنّ “البيت الشعري” هو المعيار الخارجي الوحيد والفاصل بين الشاعر وغيره؛ فمن نظم الأبيات نُصّب شاعرا، ومن كتب النثر ظل في مرتبة أدنى، حتى إن “شيلر” وصف الرّوائي في عصره بأنّه “نصف أخ للشاعر”، غير أن هذا المعيار الشكلي لم يصمد طويلا أمام التحولات الفكرية، خاصة مع بزوغ الفجر الرومانسي الذي أعاد الاعتبار للخيال والقيم الجمالية الكامنة، حيث رأى الرومانسيون الألمان في “الرواية” و«الخرافة” أقصى تجليات الشعرية، مؤكّدين أنّ الروح الإبداعية لا تحبسها القوالب العروضية، وأنّ الجوهر الفني يفيض عن حدود الوزن والقافية.
في هذا السّياق، جاهر نقاد مثل “شيلي” برفضهم القاطع للمفاهيم التقليدية، واعتبروا أنّ التفريق بين الشعراء وكتاب النثر الفني ليس سوى “خطأ شائع” ينم عن ضيق في الأفق النقدي، والواقع أن المسيرة الأدبية الحديثة، بأسماء مثل فلوبير وديكنز وكيلر، أثبتت أن النثر قد يحمل من الكثافة الشاعرية والجوهر الفني ما لا يقل منزلة عن أرفع القصائد؛ فالمسرحية التي كتبها “موليير” أو “ألميدا غاريت” نثرا، لا تفقد صفتها كعمل شعري لمجرد غياب الوزن، تماما مثل “الأشعار التعليمية” المقفاة أو التواريخ المكتوبة نظما في العصور الوسطى، التي تفتقر تماما إلى الروح الشعري وللخيال الخلاق، وبهذا، انتقل البحث من “المعيار الشكلي” الخارجي إلى “المعيار الجوهري” الذي يبحث عن قدرة اللغة على خلق عوالم موازية، بعيدا عن مجرد رص الكلمات وتلقين المعارف.
إنّ المعيار الحقيقي الذي يفصل “الأدب الجميل” عن النصوص العلمية أو القانونية، يكمن في طبيعة “خلق الأوضاع الخاصة” داخل اللغة، فالنّص العادي يشير إلى واقع حسي أو مجرد موجود سلفا (كالإشارة إلى طقس خريفي في محادثة يومية)، بينما النص الشعري يخلق واقعه الخاص..حين نقرأ سطرا لـ “نيكولاوس ليناو” يصف سحبا معتمة، فإنّنا لا نتعامل مع أوصاف حقيقية لحالة جوية، إنما نسافر مع “أوضاع لجمل شعرية” تكتسب وجودا غير واقعي. في هذا العالم، يصبح للوقفة والنبرة وحجم السطر طاقة خاصة تسهم في بناء وحدة العمل، بحيث لو تغير شيء في اللغة، يتغير العمل برُمته.
ولقد بذل النقاد محاولات جادّة لضبط حدود الدراسات الأدبية، ولعل الفيلسوف الإيطالي “بينيديتو كروتشه” كان من أنشط المدافعين عن تحديد أضيق لموضوع الأدب، حيث طرح في كتابه “فن الشعر” رؤية تفصل بصرامة شديدة بين “الشعر” الصافي، وما أطلق عليه اسم “التعبير الأدبي”، فبالنسبة لكروتشه، لا يمكن للأدب أن يكون سوى مظهر من مظاهر الحضارة والمجتمع يشبه “اللياقة”، وهو في نظره مجرّد لباس جميل يُخلع على المشاعر الذاتية العنيفة أو التعابير الخطابية والتعليمية، وبذلك جرّد الأدب من جوهره الخاص الملازم للفن، حاصرا إياه في وظائف تنسيقية خارجية.
هذا الفصل الصّارم عند كروتشه، وضع الدارسين أمام نتيجة مفاجئة وصادمة للذائقة النقدية؛ إذ إنّه يقصي قامات إبداعية وتاريخية كبرى من دائرة “الشعر” الحقيقي، ويقذف بها في هوة “النثرية” أو “الخطابة”، وبناء على هذا المنظور الضيق، نجد أسماء مثل هوراس، وفيلدينغ، وفيكتور هوغو، وحتى موليير، يُستبعدون من مواضيع نقد وتاريخ الشعر، أو لا يُعترف بشعريتهم إلا في ومضات محدّدة من أعمالهم، ما يجعل جلّ إنتاجهم الفني متهما بالسقوط في النثرية لمجرد ارتباطه بالبناء الفني والفكري المنظم.
إلاّ أنّ هذا الموقف الكروتشي يظل محل نقد عميق؛ فالمعيار الذي اعتمدناه سابقا – وهو قدرة العمل على خلق أوضاع خاصة ومستقلة – يستوعب هؤلاء المبدعين جميعا ضمن دائرة “الأدب الجميل”، ذلك أن حقيقة النص الأدبي هو “شكل مركّب من جمل” تخلق واقعها الخاص، تجعل من إقصاء مؤلّفين كبار لمجرد مسحة خطابية أو تعليمية في أعمالهم أمرا غير صائب؛ فالأدب الرفيع هو ذلك الذي ينجح في تحويل المعاني من إشارات إلى “واقع حقيقي” إلى أوضاع لها وجود غريب وخاص يختلف جوهريا عن الواقع المباشر.
وهكذا، نصل إلى قناعة مفادها أنّ “الأدب الجميل” هو الميدان الحقيقي للدراسة الأدبية، وهو ميدان يتّسع لكل عمل ينجح في جعل اللغة غاية في ذاتها، لا مجرد وسيلة نقل.
إنّ قدرة اللغة الأدبية على صهر النغم والنبرة والوقفة في وحدة عضوية واحدة هي التي تمنح العمل شرعيته، سواء كُتب شعرا أو نثرا، وسواء حمل رسالة تعليمية أو كان انفعالا محضا؛ فالعبرة تكمن في الاستقلال الوجودي لعالم النص وقدرته على فرض أفقه الخاص على القارئ.
طريق إلى الجمال..
وتظل “القراءة الصّحيحة” والموضوعية، الجسر الوحيد المحكم الذي يربط بين حماسة الدارس الشاب، بكل ما تحمله من اندفاع عاطفي، والفهم الحقيقي العميق لطبيعة هذا الفن العظيم. إنّها قراءة لا تكتفي بالوقوف عند عتبات الإعجاب السطحي، وإنما قراءة واعية تسعى جاهدة إلى فك شيفرات النص واستنطاق صمته، محولة تلك “الحماسة” الفطرية من مجرد طاقة انفعالية مشتتة إلى أداة معرفية منضبطة، قادرة على النفاذ إلى جوهر التجربة الإبداعية دون أن تفقدها بريقها الجمالي.
هذه هي القراءة المنشودة التي تتجاوز بوعي تام مرحلة “الانفعال الساذج”..تلك المرحلة التي يتماهى فيها القارئ مع النص تماهيا عاطفيا يجعله يرى الأدب مرآة لذاته، وبدلا من ذلك، تضع القراءة الصحيحة العمل الأدبي في سياقه ككيان مستقل، فتجعله “يتحدث بوضوح” وبصوت عالٍ أمام الآخرين، بوصفه بناء لغويا موضوعيا يحمل قيمه ودلالاته الخاصة التي تستحق الكشف والتفسير. وهنا تتجلى المعجزة الكبرى التي يسعى النقد لإبرازها، وهي قدرة الأدب على تحويل اللغة من أداة تواصل يومية مبتذلة، وظيفتها الأساسية نقل المعلومات أو قضاء الحاجات المعيشية، إلى طاقة إبداعية خلاّقة، يعركها الأديب، فتتحرّر الكلمات من قيود الواقع المباشر لتصبح مادة بناء “عوالم موازية”، فلا تكون الجمل مجرد واصفات لأحداث جرت بالفعل، لأنها تتحوّل هي نفسها إلى “أحداث” تخلق واقعا جديدا له منطقه الخاص وزمانه ومكانه المستقلان.
وبناء على هذا التصور، لا يمكن للنقد الأدبي أن يكون عملية “تشريح” باردة أو ميتة للجمال، كما قد يتوهّم البعض في بداية دراستهم الأكاديمية، فالمحلّل الأدبي لا يشرح النص ليقتله، إنما يغوص فيه كي يفهم سر حياته؛ وهو في ذلك يشبه العالم الذي يدرس القوانين الخفية التي تمنح الكائن الحي حركته ونبضه. النقد هنا هو فعل استبصار يتجاوز الظاهر ليدرك كيف تتآزر النبرة، والوقفة، واختيار المفردة، في سبيل إقامة صرح فني متكامل الأركان.
إنّ النّقد يتجلّى في أرقى صوره كممارسة واعية وشجاعة، تدرك تمام الإدراك كيف تُبنى الأكوان الفسيحة من محض كلمات..إنّه الوعي الذي يدرك أن خلف كل سطر شعري أو مشهد درامي تكمن هندسة دقيقة وموهبة نظرية فذّة، استطاعت أن توحّد بين الشكل والمضمون، وبهذا، تصبح الدراسة الأدبية رحلة مستمرة من الكشف الجمالي، ويغدو الدارس شريكا في العملية الإبداعية عبر فن القراءة، محوّلا صمت الورق إلى عالم يضج بالحياة.