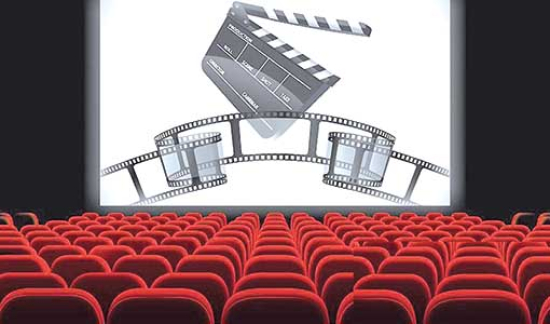ليس النقد السينمائي مجرد تقييم للأفلام، بل هو نشاط ثقافي وفكري معقد يتفاعل مع تطورات الفن، والمجتمع، والتكنولوجيا. وتشكل النظريات والمقاربات النقدية منظومة معرفية متكاملة تسمح بفك شفرة الفيلم من جوانب فنية، اجتماعية، ثقافية، وسياسية. كما يؤثر النقد على صناعة الأفلام، بالتحفيز على الابتكار، وتوجيه الجمهور إلى الأفلام ذات الجودة، وتطوير وعي المشاهد وثقافة المشاهَدَة. فيما يتطلب المشهد الثقافي الوطني تطوير بنية نقدية أكاديمية ومنهجية تواكب تطور السينما الجزائرية.
يعتبر تطور النقد السينمائي مسارا طويلا ومعقدا يعكس تطور السينما نفسها وتغيرات المجتمع والثقافة، وقد تمّ توثيقه وتحليله عبر أبحاث ومقالات أكاديمية رصينة نشرت في مجلات ومؤسسات بحثية عالمية.
تطوّر النّقد السينمائي
يعود تاريخ النقد السينمائي إلى أواخر القرن التاسع عشر مع ظهور السينما كوسيلة إعلامية جديدة، حيث بدأت المجلات المتخصصة في أوائل القرن العشرين بنشر مراجعات نقدية للأفلام بشكل منتظم، وهو ما مهد الطريق لظهور نقاد محترفين.
في بدايات القرن العشرين، افتقر النقد السينمائي إلى المنهجية الأكاديمية، واقتصر على مجرد تقييمات سطحية أو آراء شخصية، ومع مرور الوقت تطور النقد ليصبح مجالا معرفيا قائما بذاته، يستند إلى نظريات فنية وثقافية متخصّصة. في ثلاثينيات القرن الماضي، مع تحول السينما إلى صناعة ترفيهية ضخمة، بدأ النقد السينمائي يكتسب شعبية أوسع، وظهرت أسماء نقاد بارزين (مثل أوتيس فيرغسون وجيمس آجي) الذين عملوا في الصحف المحلية، مؤسسين لمدرسة نقدية أكثر احترافية.
في منتصف القرن العشرين، شهد النقد السينمائي تحولات جذرية مع بروز مدارس نقدية أكاديمية مثل مدرسة “Cahiers du Cinéma” (كراسات السينما) الفرنسية التي أسسها نقاد مثل أندريه بازان (André Bazin) وجان لوك غودار (Jean-Luc Godard)، والتي ركّزت على تحليل المخرجين (auteurs) كفنانين مبدعين، مع التأكيد على أهمية الإخراج كعامل أساسي في بناء المعنى السينمائي. كما أسهمت هذه المدرسة في تأسيس مفهوم “النقاد المخرجين” الذين يجمعون بين النقد والإبداع السينمائي.
على المستوى الأكاديمي، برزت أسماء مثل الروسي سيرغي إيزنشتاين الذي أسس نظرية المونتاج كأداة فنية مركزية في صناعة الفيلم، والأمريكي ديفيد بوردويل (جامعة واشنطن)، الذي طور منهجيات تحليلية دقيقة للنص السينمائي، مع التركيز على البنية السردية والأسلوبية.
أما في العقود الأخيرة، فقد أصبح النقد السينمائي جزءًا من الدراسات الثقافية الأوسع، حيث يتناول الأفلام في سياقاتها الاجتماعية والسياسية، ويستخدم نظريات متعددة مثل البنيوية، ما بعد البنيوية، النقد النسوي، والنقد الماركسي. كما شهد النقد السينمائي أزمة مستمرة في تحديد سلطته وشرعيته، وهو ما يناقشه ماتياس فراي (جامعة غوته، فرانكفورت) في كتابه الصادر حديثا “الأزمة الدائمة للنقد السينمائي” (The Permanent Crisis of Film Criticism)، حيث يعرض، كما يظهر من عنوان الكتاب، كيف أن النقد السينمائي يمر بأزمات متكررة تتعلق بمكانته في الثقافة الشعبية، وتحديات السلطة النقدية في ظل تطور وسائل الإعلام الرقمية وانتشار المحتوى غير الرسمي.
نظريات ومقاربات
في مجال النقد السينمائي، نجد أنّ النظريات والمقاربات النقدية هي الركيزة الأساسية لفهم وتحليل الأفلام بشكل عميق ومنهجي، إذ توفر أطرا فكرية متعددة تسمح بتفسير الفيلم ليس فقط كمنتج فني، بل كظاهرة ثقافية واجتماعية تعكس وتؤثر في مجتمعاتها. وقد تطورت هذه النظريات عبر الزمن، متأثرة بتغيرات السينما والمجتمع، لتمثل مدارس فكرية متنوعة تقدم رؤى مختلفة حول كيفية قراءة الفيلم وتأويل معانيه.
في بداية القرن العشرين، برزت “النظرية الشكلانية” (Formalist Film Theory) التي تركز على الشكل الفني للفيلم، وتحليل العناصر البصرية والسمعية مثل الإضاءة، التكوين، المونتاج، والإيقاع السينمائي، باعتبارها الوسائل التي تخلق المعنى السينمائي. هذه المدرسة، التي تعود جذورها إلى نقاد مثل الألماني رودولف أرنهايم، ترى في الفيلم عملا فنيا قائما على البناء الفني وليس مجرد تصوير للواقع.
بعد ذلك، في منتصف القرن العشرين، ظهرت “النظرية الواقعية” (Realist Film Theory) التي تأثرت بحركات مثل الواقعية الإيطالية، وركزت على قدرة الفيلم على تمثيل الواقع بصدق وواقعية، مع اهتمام خاص بالظروف الاجتماعية والسياسية المحيطة. هذه المدرسة ترى أن الفيلم يجب أن يعكس الحياة اليومية للناس العاديين، ويستخدم تقنيات تصوير طبيعية وأماكن حقيقية، كما في أعمال روبرتو روسيليني.
مع تطور الفكر النقدي، برزت “النظريات البنيوية وما بعد البنيوية” التي تحلل البنية السردية واللغوية للفيلم، مستعينة بمفاهيم من علم اللغة والسيميولوجيا. من أبرز رواد هذه المدرسة الفرنسي كريستيان ميتز الذي طبق مفاهيم السيميائية على السينما، معتبرا الفيلم نظاما لغويا يمكن تفكيكه وتحليله لفهم كيفية إنتاج المعنى.
في أواخر القرن العشرين، ظهرت نظريات نقدية تدمج التحليل السياسي والاجتماعي، مثل “النظرية الماركسية” التي تركز على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والطبقية في الفيلم، وتحلل كيف تعكس الأفلام أو تتحدى البنى الاقتصادية السائدة.
واستجابة لعصر العولمة والتقنيات الرقمية، ظهرت “نظرية ما بعد الحداثة” لتتناول التداخل بين الأنواع السينمائية، التلاعب بالسرديات التقليدية، والتشكيك في الحقيقة الموضوعية، مع التركيز على التنوع الثقافي والهوية المتعددة. وتعكس هذه النظرية التغيرات الاجتماعية والثقافية في القرن الحادي والعشرين، وتدرس كيف تؤثر التكنولوجيا الرقمية على صناعة وتلقي الأفلام.
نشير في الأخير إلى رأي د . محمد بدير (جامعة تلمسان) بأن منهج النقد السينمائي، على الرغم من حداثته واختلافه عن المناهج النقدية الأخرى، فهو يستمد جذوره وتقاليده منها. ويضيف الباحث: “الناقد السينمائي لا يستطيع أن يحكم على الفيلم إلا إذا كان مطلعا على دقائقه عارفا بأسراره وخفاياه، ولسنا نعني أن يكون الناقد خبيرا ممارسا لفنون الشعر والمسرح والرواية والموسيقى والفن التشكيلي، وإنما يجب أن يكون ملما إلماما كافيا بوظائف هذه الفنون التي تعد القاعدة العامة التي يؤسس عليها الفن السينمائي”.
كيف يؤثّر النّقد السّينمائي على صناعة الأفلام؟
يؤثر النقد السينمائي بشكل مباشر وغير مباشر على صناعة الأفلام، من حيث الإنتاج الفني، والتوجهات الإبداعية، والجوانب الاقتصادية.
ومن بين تمظهرات هذا التأثير، “تحفيز الإبداع والابتكار الفني”، إذ يعمل النقد السينمائي على تقديم تحليلات معمقة للأفلام، ويساعد ذلك صناع الأفلام على فهم أعمق للبنية السردية والأسلوبية، وبالتالي دفعهم لتجريب تقنيات سردية وبصرية جديدة. وهو ما يوضّحه ديفيد بوردويل حينما يعتبر أنّ النقد السينمائي يعزز من وعي المخرجين بالبُنى السردية والأساليب الفنية، ممّا يؤدّي إلى إنتاج أفلام أكثر تعقيدًا وجاذبية.
كما نشير إلى دور النقد في توجيه الجمهور وتأثيره الاقتصادي، حيث تؤثر التقييمات النقدية الإيجابية على إقبال الجمهور، ما ينعكس على نجاح الفيلم تجاريا. وفي هذا الصدد، يعتبر الباحث ماك ويرتر (جامعة تكساس) أنّ “التقييمات النقدية في المجلات العلمية المحكمة تؤدي إلى زيادة إيرادات الأفلام، ويشجع ذلك على دعم الأفلام الفنية والمبتكرة”.
ويسهم النقد السينمائي في “تطوير ثقافة المشاهدة السينمائية”، إذ يساعد النقدُ الجمهورَ على تطوير قدرة تحليلية تمكنه من فهم طبقات الفيلم المختلفة، فيرفع مستوى التذوق الفني ويخلق جمهورا أكثر وعيا وتطلبا، وطلبا للأعمال ذات القيمة الثقافية، وفي ذلك تقول الباحثة إسترلا سيندرا (جامعة لندن)، والتي اشتغلت كثيرا على السينما الإفريقية، إن النقد السينمائي يمكّن المشاهد من رؤية الفيلم بعيون نقدية واعية، موسعا دائرة التأثير السينمائي.
ويشجّع النقد التنوع والابتكار في صناعة السينما، حيث يؤكد، وفقا للألماني هانس فراي، على أهمية تناول قضايا اجتماعية وثقافية متنوعة، ويحفز على استكشاف أنماط سردية وتقنيات جديدة، داعما السينما المستقلة ومعززا التجارب السينمائية غير التقليدية.
النّقد السينمائي في الجزائر
لا داعي للتذكير بالإرث السينمائي الغني التي تزخر به الجزائر، فالسينما الجزائرية، من الناحية التاريخية، لعبت دورا مهما في تشكيل الوعي الثقافي والسياسي، خاصة من خلال الأفلام التي تناولت ثورة التحرير. وبعد الاستقلال، شهد النقد السينمائي ازدهارا نسبيا عبر الصحف والمجلات (مجلة “الشاشتان” مثالا)، والتي كانت منصة مهمة للنقاش والحوار النقدي حول الأفلام الوطنية والأجنبية. لكن مع مرور الوقت، تراجع دور نوادي ومتاحف السينما، وقلّ الحوار النقدي الجماعي.
في هذا الصدد، وقبل حوالي عشرة أعوام، قدم الدكتور علال عماري (جامعة وهران 1) رسالة دكتوراه تحت عنوان “النقد السينمائي في الجزائر بين الأكاديمية والانطباعية”، وكما يتضح من العنوان، قسّم الباحث النقد إلى انطباعي وصفي يكتفي بكتابات بسيطة وانطباعات شخصية سطحية، وأخبار إعلامية فنية، دون تحليل أو تفسير لعدم امتلاك الآليات الفنية الصحيحة، وإلى قسم ثانٍ هو النقد الأكاديمي المبني على الأدوات والمناهج العلمية. واعتبر الباحث أن النقد في الجزائر غالبا ما يكون انطباعيا أو وصفيا، ويعاني من ضعف التأسيس الأكاديمي، مما يحد من تأثيره على تطوير صناعة السينما المحلية.
وخلص الباحث، الذي دعا إلى التأسيس لصحافة متخصّصة، خلص إلى أن النقد لا يساير تماما الإنتاج السينمائي، رغم انتعاش هذا الأخير مؤخرا بسبب عودة دعم الدولة للقطاع، لكن ذلك “لم يحرّك طبقة النقاد السينمائيين”.
في الختام، نقول إنّ النقد السينمائي في الجزائر يعكس واقعا مركبا بين إرث سينمائي غني وتحديات نقدية منهجية، حيث يبقى معتمدا على جهود فردية، مع وجود حاجة ملحة لتطوير بنية نقدية أكاديمية ومنهجية تواكب تطور السينما الجزائرية وتعزز من دورها الثقافي والفني.