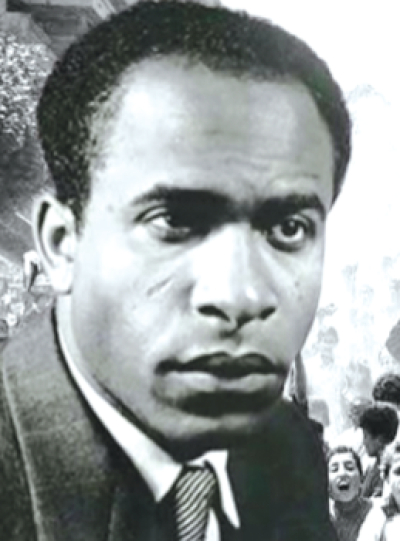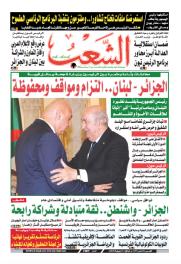نضــــــــــــال الشعـــــــــــوب المستعمـــــــــــرة هـــــــــــو تجسيــــــــــــد البحــــــــث عـــــــــــــــن الحريـــــــــــــــــة المسلوبــــــــــــــــــة
لم تكن تقديم جان بول سارتر لكتاب فرانتز فانون “معذبو الأرض” (1961) مجرد تمهيد أكاديمي أو توصية بكتاب، بل كان وثيقة فلسفية وسياسية حادة، تعكس عمق التزامه بقضايا التحرر من الاستعمار وتفكيك بنيانه المعقد، في فترة كانت رياح التحرر تجتاح العالم بأسره، وتحديداً في الجزائر التي كانت تخوض حرباً ضروساً من أجل استقلالها.. سارتر قدم تحليلاً وجودياً لاذعاً للعنف الاستعماري، ما وضع فانون وكتابه في قلب النقاش الفلسفي والسياسي العالمي، ودعم هذا الطرح بمقولات تعارض بحدة نظريات الكولونيالية التقليدية، وتبشر بضرورة مناهضة “الكولونيالية الجديدة” في عالم ما بعد الاستقلال.
جاءت مقدمة جان بول سارتر لكتاب فانون في ذروة الثورة الجزائرية المباركة، حين كان الثوار الجزائريون يلقنون المستعمر الغاشم أروع دروس الشجاعة والإقدام والحس الإنساني الذي يفتقد إليه المستعمر وأذياله؛ لهذا، كان التقديم بمثابة مواجهة أيديولوجية شاملة بين مشروع استعماري فرنسي “قديم”، يستند إلى الفكرة البهتان (المهمة الحضارية)، وبين حركة تحرر وطني تتبنى مبادئ تقرير المصير والعدالة.. كانت فرنسا، القوة الاستعمارية الأكبر في العالم آنذاك، تواجه تحدياً غير مسبوق في مستعمراتها الإفريقية والآسيوية، قابلتها بممارسات قمعية وحشية، بلغت ذروتها في التعذيب المنظم والإبادة الجماعية.
في هذا السياق المتأزم، برز فرانتز فانون كطبيب نفسي ثوري، من أصل مارتينيكي، شهد وعاش تجربة الاستعمار بعمق، وكرّس حياته لدراسة الآثار النفسية المدمرة للاستعمار والعنف على المستعمَرين، وكيف أن هذا العنف لا يقتصر على الجانب المادي، بل يتغلغل في بنية الشخصية والعقل، محدثاً “عصاباً استعمارياً”.
لم يكن غريباً أن يتبنى سارتر، الفيلسوف الوجودي البارز، موقفاً جذرياً ومتحيزاً بوضوح إلى جانب الشعوب المستعمرة، فجوهر الفلسفة الوجودية السارترية يقوم على مبدأ أن “الوجود يسبق الماهية”، بمعنى أن الإنسان يولد حراً ومسؤولاً عن تحديد ماهيته واختياراته، ويرى سارتر أن القهر الاستعماري هو نقيض هذه الحرية الوجودية، فهو يسلب الفرد المستعمَر حقه في تحديد ذاته، ويفرض عليه ماهية مشوهة ومهينة، وبالتالي، فإن نضال الشعوب المستعمرة هو تجسيد للبحث عن هذه الحرية المسلوبة، وأن العنف الثوري، وإن كان مؤلماً ومدمراً، هو فعل وجودي يكسر أغلال التشييء والاستلاب، ويستعيد كرامة الفرد والمجتمع. يرى سارتر أن “حرية الآخر هي حرية الذات”، وبما أن المستعمر قد سلب حرية الآخر، فقد سلب جزءاً من إنسانيته أيضاً.
تفكيك الأيديولوجيا الكولونيالية..
ينطلق سارتر في مقدمته لكتاب فانون من تعرية لاذعة للأيديولوجيا الكولونيالية التي صورت أوروبا كـ«مهد للإنسانية والحضارة”، بينما كانت تمارس أبشع أشكال الوحشية، ويشير سارتر بوضوح إلى ذلك حين يقول: “لم يمض وقت طويل، كانت الأرض تضم ملياري نسمة، خمسمائة مليون رجل ومليار ونصف المليار من السكان الأصليين.. الأولون يملكون الكلمة، والآخرون يستعيرونها”.. هذه الكلمة القوية تلخص بشكل مكثف العلاقة الهرمية القائمة على السلطة واللغة، حيث تحتكر القوى الاستعمارية حق التعبير، وتفرض سرديتها الخاصة، بينما يُحرم المستعمَر من صوته وهويته الأصيلة.
ويصف سارتر ببراعة كيف قامت النخب الأوروبية بـ«صناعة نخبة من السكان الأصليين، يتم اختيار المراهقين، ويوضع على جباههم، بالحديد الأحمر، مبادئ الثقافة الغربية، ويحشر في أفواههم كمامات صوتية، كلمات كبيرة لزجة تلتصق بالأسنان”.. هؤلاء – يقول سارتر - هم “الأكاذيب الحية”، فقد كانوا يُعادون إلى ديارهم “مخدوعين”، ليكونوا مجرد صدى باهت لخطاب المستعمر، منقطعين عن جذورهم الثقافية ومجتمعاتهم، علما أن هذه العملية لم تكن تهدف إلى “تثقيف” المستعمَر بالمعنى الحقيقي للكلمة، بل كانت تهدف إلى “تشييئِه” وسلبه إنسانيته وذاتيته، وتحويله إلى كائن مستلب، يخدم مصالح الاستعمار.
تأتي هنا مقولات فانون لتؤكد هذا الطرح وتدعمه بعمق تحليله النفسي والاجتماعي في “معذبو الأرض”، (وكذلك في كتاب “بشرة سوداء، أقنعة بيضاء”)، إذ يرى فانون أن الاستعمار “ليس مجرد احتلال للأراضي، بل هو احتلال للعقول”، ويضيف: “الاستعمار لا يكتفي بإخضاع شعب، بل يدمر ثقافته وقيمه وأنظمته المحلية، ويُدخل مفاهيم الدونية والعرقية في وعي المستعمَر نفسه”.. هذه الرؤى تتقاطع بشكل حاسم مع تحليل سارتر لـ«نفاق الإنسانية الأوروبية” التي “تدعي العالمية”، بينما “تتخذ من العنصرية تخصصا”.. كان كل من سارتر وفانون يريان أن هذه الإنسانية المزعومة ليست سوى قناع متقن يخفي وراءه وحشية الاستغلال، القمع، والتطهير الثقافي.
وقد نذهب أبعد من ذلك في التاريخ، ونقول إن أصل “العنصرية” في فرنسا، قديم قدم أطروحة آرتير دوغوبينو، فهو الذي تمحور فكره حول “التمايز والتراتبية” باعتبارهما ليسا مجرد ظواهر اجتماعية أو تاريخية، بل هما قانون طبيعي أزلي يشمل كل المخلوقات، من حيوان ونبات وجماد، وصولاً إلى البشر. بناءً على هذا التصور، قسم غوبينو البشر إلى ثلاث “أجناس” رئيسية: الأبيض، والأصفر، والأسود، وادعى أن هذه الفروق ليست مجرد اختلافات شكلية، بل هي حواجز طبيعية تحدد القدرات العقلية، الأخلاقية، والجمالية لكل عرق.
ولقد أمعن دو غوبينو في طرحه العنصري الأخرق، فوضع العرق “الأبيض” في قمة هذه التراتبية، مدعياً أنه الأكثر تفوقاً من حيث الذكاء والجمال والقوة الإبداعية. وذهب إلى أبعد من ذلك، حين زعم أن أي حضارة لا يمكن أن تزدهر إلا بوجود (أجداده الحمقى). بالمقابل، وصف الأجناس الأخرى بأنها أقل شأناً؛ فالأجناس “السوداء” كانت في رأيه قوية جسدياً لكنها غير قادرة على التفكير الذكي، بينما لم تكن هناك حضارات عفوية بين “الأجناس الصفراء”، وهذا بهتان فنّده التاريخ، غير أن فرنسا انغمست فيه وقت كانت عرابة الكولونيالية، وما زال الحالمون بالقدرة على استعباد الناس منغمسون في هذا الفكر الأحمق إلى يوم الناس هذا..
الفعـــل الوجـــودي للتحـــــــرّر
تعتبر نقطة العنف الثوري الأكثر إثارة للجدل، والأشد تأثيراً في مقدمة سارتر، فهو لا يرى العنف الذي فرضه المستعمر كفعل أحادي الجانب، بل يرى أن العنف الذي يمارسه المستعمَر هو استجابة حتمية، وآلية ضرورية للتحرر من “العصاب الاستعماري” الذي تحدث عنه فانون.
يقول سارتر بوضوح: “إن المستعمَر يشفى من العصاب الاستعماري بطرد المستعمر بالسلاح”. هذا ليس دعوة للعنف من أجل العنف ذاته، بل هو تحليل لآلية التحول النفسي والوجودي التي تحدث نتيجة لكسر أغلال القهر. فالعنف، في هذا السياق، هو عملية تطهيرية تكسر حالة الخضوع والاستلاب التي فرضها المستعمر على المستعمَرين.
يستمد سارتر هذه الفكرة المحورية من فانون نفسه، الذي يؤكد أن العنف “عملية تطهيرية.. لأنه يحرر السكان الأصليين من الدونية، ومن حالة اليأس والكسل، ويستعيد لهم كرامتهم ووعيهم بذاتهم”، ذلك أن فانون يرى “العنف الثوري في الكفاح من أجل التحرر ليس خياراً، بل هو ضرورة وجودية لتفكيك البنى النفسية للاستعمار”..فالعنف يكسر صورة المستعمر كـ«سيد”، ويعيد المستعمَر إلى موقعه كـ«ذات فاعلة”، ثم إن “العنف المضاد” المقصود، لم يكن بادئا بظلم، وإنما هو دفاع شرعي عن النفس، ضد العنف الذي فرضه المستعمر الغاشم.
يسوّغ سارتر هذا الموقف الجذري بقوله: “عندما ينفجر غضبه (المستعمَر)، يستعيد شفافيته المفقودة، ويعرف نفسه بالقدر الذي يصنع فيه ذاته”. فالعنف المضاد ليس مجرد تكتيك عسكري لتحقيق النصر، بل هو إعلان عن الذات، وتأكيد على الوجود الحر، وتحويل “الأنا” المستلبة إلى “أنا” ذات سيادة.
ولا يتردّد سارتر في القول بأن “سلاح المقاتل (المدافع عن نفسه) هو إنسانيته”، وأن “قتل الأوروبي هو ضرب عصفورين بحجر واحد، إزالة الظالم والمظلوم في آن واحد: يبقى رجل ميت ورجل حر”، وهذا يمثل تحدياً صارخاً للمفاهيم التقليدية للأخلاق، لكنه يضعها في سياق النضال من أجل التحرر المطلق من القهر، حيث يصبح العنف وسيلة للوجود المستقل.
نقـــــــد الكولونياليـــــــة الجديـــــــــدة
لم يكتف سارتر بنقد الكولونيالية القديمة القائمة على الاحتلال المباشر، بل ألمح بذكاء إلى مخاطر الكولونيالية الجديدة، وإن لم يستخدم المصطلح صراحة، فقد نبه إلى أن “الليبراليين” الأوروبيين و«اليسار المتروبولي” الذين يدعون التعاطف مع الشعوب المستعمرة، قد يقعون في فخ النفاق أو يسعون إلى فرض أشكال جديدة من الهيمنة، ويشير إلى أنهم “لا يدينون ثورتهم، لكنهم يطالبون المقاتلين بأن يكونوا ‘فرساناً’ ليثبتوا أنهم بشر”. هذا التطلب الأخلاقي من قبل القوة المهيمنة يمثل شكلاً من أشكال التحكم الخفي، أو ما يمكن تسميته بـ«الكولونيالية الجديدة” التي لا تعتمد على الاحتلال العسكري المباشر، بل على الهيمنة الاقتصادية، الثقافية، والسياسية من خلال آليات معقدة.
هذه النقطة تتقاطع بشكل حاسم مع تحليل فانون العميق لما بعد الاستقلال في “معذبو الأرض”، إذ يحذر بمرارة من ظهور “برجوازية” فاسدة وغير منتجة تحل محل المستعمر القديم، وتستمر في استغلال شعبها، وبالتالي تفتح الباب لأشكال جديدة من التبعية.
يرى فانون أن “الوعي الوطني ليس هو نهاية الطريق، بل هو بداية الطريق لوعي اجتماعي شامل ونضال مستمر ضد كل أشكال الاستغلال”، فالكولونيالية الجديدة، في جوهرها، تستغل ضعف الهياكل الوطنية الجديدة، وتديم آليات الاستنزاف من خلال القروض، المساعدات المشروطة، الشركات متعددة الجنسيات، والتبعية التكنولوجية والثقافية، وغالباً ما تتخذ طابع “الشراكة” أو “التعاون” بينما تخفي وراءها علاقات قوة غير متكافئة.
المسؤولية الوجودية..مرآة التاريخ
على الرغم من لهجته اللاذعة والقاسية تجاه المستعمِر، فإن سارتر لا يكتب فقط للمستعمَرين، بل يوجه خطابه بوضوح إلى الأوروبيين أيضاً.. يقول: “أيها الأوروبيون، افتحوا هذا الكتاب، ادخلوا فيه”.. إنه يدعوهم إلى قراءة فانون لسببين أساسيين: الأول هو أن فانون “يشرح لكم إخوانه ويفكك لهم آلية استلاباتنا: استفيدوا من ذلك لتكتشفوا أنفسكم في حقيقتكم كأشياء”.
إن رؤية أنفسهم من منظور الضحية، وفهم كيف أن استغلال الآخر قد حولهم هم أنفسهم إلى “جلادين”، هي عملية مؤلمة ولكنها ضرورية لإدراك حقيقة “ما فعلناه بأنفسنا” من خلال ممارسات الاستعمار.
في نهاية التقديم، يتحدث سارتر عن “فرنسا التي كانت يوماً اسماً لبلد، يتمنى أن لا تصبح في عام 1961 اسماً لعصاب.” ويضيف “الخجل والخوف سوف يشوهان الشخصية ويفككان الكيان.”
السبب الثاني هو أن فانون “هو الأول منذ إنجلز الذي يسلط الضوء على قابلة التاريخ”، ويؤكد سارتر أن عنف فانون ليس مجرد “عاصفة عبثية” أو “إحياء لغرائز وحشية”، بل هو “الإنسان نفسه يعيد تكوين ذاته” من خلال صراع الإرادات.. إنه يؤمن بأن التاريخ يصنع من خلال الفعل الثوري، وأن المستعمر قد أيقظ قوة تاريخية لا يمكن إيقافها.. هذه دعوة للأوروبيين لمواجهة مسؤوليتهم الوجودية عن أفعالهم وتأثيرها على العالم، ولأن يدركوا أن “العنف، مثل رمح أخيل، يمكنه أن يشفي الجروح التي أحدثها”..
ختــــــامــــــــــــــــــــــــا..
قدمت مقدمة جان بول سارتر لكتاب فرانتز فانون “معذبو الأرض” تحليلاً وجودياً وسياسياً عميقاً لا يزال صداه يتردد حتى اليوم، فقد كشفت زيف الخطاب الإنسانوي الأوروبي الكولونيالي، ودافعت عن حق الشعوب المستعمرة في استعادة كرامتها من خلال العنف الثوري كفعل وجودي ضروري، وحذرت بوضوح من فخاخ أشكال الاستعمار الجديدة والتبعية الخفية.
لقد كان سارتر وفانون صوتين جريئين في مواجهة الظلم، وقد ساهمت رؤاهما بشكل حاسم في تشكيل تيار فكري نقدي مناهض للكولونيالية، لا يزال يلهم الحركات التحررية والفكر النقدي حول العالم في سعيهما نحو عالم أكثر عدالة وتحرراً من كل أشكال الهيمنة، سواء كانت قديمة أم جديدة، عسكرية أم اقتصادية، ثقافية أم سياسية. إن إرثهما المشترك يمثل دليلاً على أن الفلسفة يمكن أن تكون أداة قوية للتغيير الاجتماعي والسياسي.
يجب أن نشير إلى أن الفكر العنصري الذي يؤسس لأطروحات الكولونيالية الفرنسية المقيتة دُحض علمياً بشكل قاطع، مع التقدم في علم الوراثة وعلم الإنسان، وكان الفيلسوف الجزائري امحند تازروت قد أقام الحجة والبيان على سخافته، في كتاب شهير وسمه بعنوان: “بيان ضد العنصرية”، قد تسمح لنا الظروف بالعودة إليه.