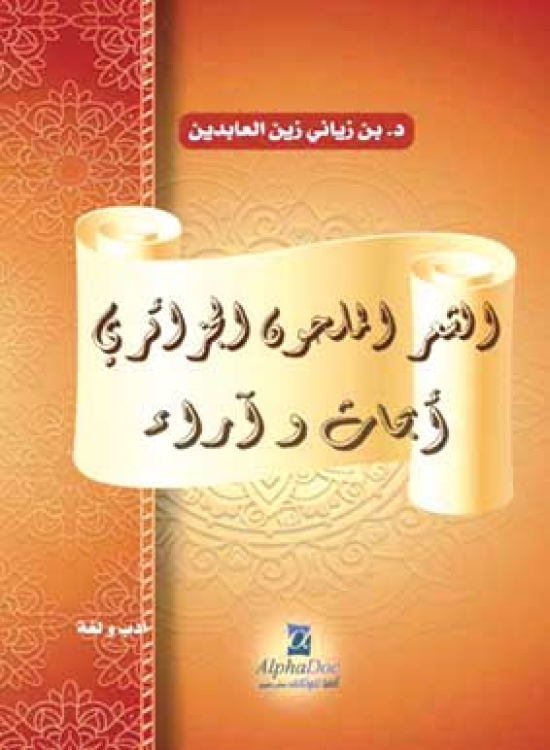صدر حديثا، عن دار “ألفا للوثائق”، كتاب “الشعر الملحون الجزائري، أبحاث وآراء”، للدكتور زين العابدين بن زياني. ويتطرق الكتاب إلى نشأة الشعر الملحون الجزائري، وأنواعه، وأشكاله، وظواهره، وموضوعاته. كما يسعى إلى إبراز أبحاث وآراء أهم الباحثين الجزائريين والعرب في مجال الدراسات الشعبية، بالتحليل والمناقشة العلمية، وكذا التعريف الموجز لبعض فحول الشعر الملحون بالجزائر.
في إصداره الجديد “الشعر الملحون الجزائري ــ أبحاث وآراء”، يتطرق الدكتور زين العابدين بن زياني إلى واحد من أهم مكونات التراث الثقافي الجزائري.
وعن هذا العمل، الصادر عن دار “ألفا للوثائق” في 132 صفحة، يقول الدكتور بن زياني: “غايتُنا في هذا الكتاب، أنْ نُحْسِنَ في طرح نَظْرَتنا ورأينا في موضوعاته المختارة، راجين أن نقدّم إضافة لمكتبة أدبنا الشعبي”.
ويؤكد المؤلف، في مقدمة كتابه، أن الشعر الملحون وليد الثقافة الشعبية، وشكل من أشكال التعبير في الأدب الشعبي المتداول على ألسنة العامة بطريقة شفاهية، متوارثا جيلاً بعد جيل. وتشمل أشكال التعبير في الأدب الشعبي، الفنون القولية: كالأمثال والألغاز والحكايات والخرافات والأغاني والنكت والشعر الملحون (الشعبي).. وهذه الأشكال الأدبية لا تُسند لفرد بعينه، بل تتشارك في إبداعها وإنتاجها جماهير عريضة على مرّ الزمان والمكان.
ويضيف بن زياني أن الشعر الملحون الجزائري يشكل جزءًا هاما من التراث العربي والإنساني، كونه يعبر عن عاطفة الإنسان قبل كل شيء، فهو شعر وجداني بالدرجة الأولى، إذ تبرز فيه شخصية الشاعر سواء من خلال البوح عن إحساساته ومشاعره الذاتية، أو من خلال البوح عن إحساسات ومشاعر الآخرين تعبيرًا صادقًا عن خلجات النفس.
كما يزخر الشعر الملحون الجزائري بقِيم فنية وموضوعاتية، معبرًا بها عن آلام وآمال الجماهير الشعبية في قالب أدبي شعبي يتماشى مع مستواها اللغوي والفكري والثقافي والحضاري. وهو جدير بأن يكون عملا أدبيا لأنه نابض بالحياة، يعبّر عن تجربة ذاتية أو مجموعة من التجارب الإنسانية التي يمر بها الشاعر في حياته أو في حياة من يعايشهم، فيهتز وجدانه ويثير في الوقت ذاته اهتزازات وانفعالات السامع أو القارئ بكل تلقائية.
ووفقا للكاتب، فإن هذه الرؤية للحياة والأدب، يترجمها الشعر الملحون، الذي يُعدّ أقربَ الفنون الأدبية إلى عواطف الناس وأهوائهم، مصوّرا خواطرهم ومشاعرهم، وكل ما تنبض به قلوبهم، سواءً في حالتيْ انبساطها أو انقباضها، فهو لسان الجماعة ومستودع مآثرها ومفاخرها وأمجادها وعاداتها وتقاليدها، على مر الزمان والمكان.
ويرى الكاتب أن شاعر الملحون الجزائري قد وجد في بيئته المحلية مناخا صالحا للتعبير عن عواطفه وانشغالاته بلغة سهلة وأسلوب بسيط لا يتطلب معرفة الكتابة وإتقان قواعد اللغة العربية، فعبر بعفوية عن عمق المعاناة ونضج التجربة ورهافة الإحساس الفردي والجماعي، فكان شعرهُ سجلا حافلا بالأحداث نتعرف من خلاله على المستوى الفكري والشعوري للعباد وللبلاد، يجد الباحث فيه نتاجا شعريا غزيرا بموضوعاته المتنوعة ومضامينه الجديرة بالتحليل والدراسة.
وعليه، جاء هذا الكتاب ليبرز أبحاث وآراء أهم الباحثين الجزائريين والعرب في مجال الدراسات الشعبية، كعبد الحميد بورايو، ومحمد سعيدي، وعبد الله ركيبي، والتلي بن الشيخ، والعربي دحو، ونبيلة إبراهيم، وأحمد مرسي، ومحمد المرزوقي، وغيرهم، بالتحليل والمناقشة العلمية، وكذا التعريف الموجز لبعض فحول الشعر الملحون بالجزائر، كنموذج للدراسة، لتعُم الفائدة للباحثين والطلبة، محاولين وضعها في سياقها المعرفي الخاص بها.
ويضم هذا الكتاب مدخلا عاما تناول فيه الكاتب نشأة الشعر الملحون الجزائري، متطرقا فيه إلى ثلاثة آراء. كما يضم ثلاثة فصول: أولها “مفهوم الشعر الملحون”، الذي قسم بدوره إلى ثلاثة مباحث هي: “المدلول اللغوي للملحون”، و«أصل تسمية الشعر الملحون”، و«إشكالية المصطلح”.
أما الفصل الثاني “الشعر الملحون أنواعه وأشكاله”، فقد تضمن ثلاثة مباحث، يتطرق أولها إلى “أنواع الشعر الملحون”، وهي نوعان: الشعر البدوي، والشعر الحضري. أما المبحث الثاني “أشكال القصيدة الملحونة”، فيتطرق إلى الشكل التقليدي، وشكل الموشحات، وشكل الأزجال. فيما يعالج المبحث الثالث إشكالية ضبط أوزان الشعر الملحون.
ثم نجد الفصل الثالث “من ظواهر الشعر الملحون الجزائري”، وهو مقسم إلى مبحثين: مبحث أول بعنوان “ظاهرة التأريخ والتوقيع في الشعر الملحون الجزائري” (تأريخ القصائد، وتوقيع القصائد)، أما المبحث الثاني “موضوعات الشعر الملحون الجزائري”، فيسلط الضوء على الشعر الديني، والوطني، والعاطفي، والاجتماعي، وشعر الرثاء، وأخيرا شعر الطبيعة.