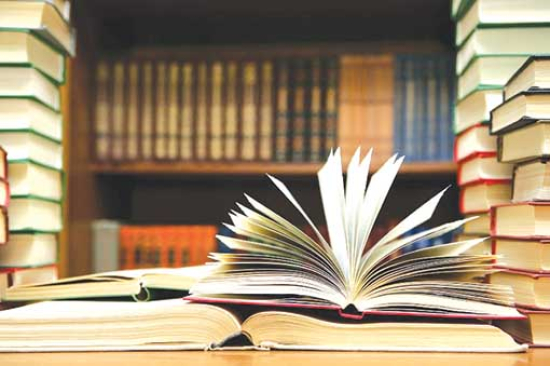الرهان.. مواكبة التحوّل التكنولوجي وضبطه معرفيّا وقيميّا..
بين البُعد التأويلي العميق ومعيار “الإعجابات” و”المشاهدات”
منذ مطلع القرن الحالي، عرف الإعلام الثقافي تحوّلات عميقة في بنيته ووظائفه، نتيجة التقدّم السريع للوسائط التكنولوجية الحديثة.. تحوّلات يتقاطع فيها الإبداع البشري مع منطق الخوارزميات، ويزدهر فيها المحتوى ضمن معايير تجارية أكثر من معاييره الرمزية أو الفكرية. من أجل ذلك، لم يعد رهان المستقبل يكمن في مقاومة الوسائط، بل في إعادة هندسة علاقتنا بها على أسس نقدية وثقافية جديدة.
شهد الإعلام عموما، والإعلام الثقافي خصوصا، في العقدين الأخيرين، تحوّلات بنيوية عميقة نتيجة الانتقال من الوسائط التقليدية إلى الوسائط التكنولوجية الحديثة، التي أعادت تشكيل البنية التواصلية والثقافية في آنٍ واحد.
مقاربات لاستيعاب تأثير التكنولوجيا
في هذا السياق، تتجلى الحاجة إلى مقاربات نظرية تُسهم في فهم هذا التحوّل، وفهم تأثير الوسائط التكنولوجية الحديثة في الإعلام الثقافي من حيث آليات إنتاجه وتمثيله وتوزيعه، والتحدّيات التي تطرحها هذه البيئة الجديدة. من أجل ذلك، وجب الاعتماد على المقاربات النظرية الكلاسيكية (ماكلوهان، كاستلز، هول) والمعاصرة (مانوفيتش، فان ديك، بوخر).
في السياق التقليدي، كان الإعلام الثقافي يُنتَج من قِبل المؤسسات الثقافية الكبرى والمثقفين، وتنتقل رموزه عبر قنوات مرجعية كالصحافة الورقية والإذاعة والتلفزيون.. غير أن هذه العلاقة تغيّرت جذريًا مع صعود البيئة الرقمية. وفقًا لما أشار إليه مانويل كاستلز في “المجتمع الشبكي” (2001)، أصبح المستخدم في العصر الرقمي منتجًا للمحتوى الثقافي وليس مستهلكًا فقط، ما أدّى إلى تشكّل فضاء تشاركي ولا مركزي تتقاطع فيه الهويات والمرجعيات الثقافية.
يتقاطع هذا مع طروحات مانوفيتش (2020) الذي يصف هذه الظاهرة بـ«الحوسبة السحابية الثقافية”، حيث تُنتج الثقافة في بيئة رقمية تحليلية ضخمة، يتم فيها استخراج أنماط الثقافة من خلال البيانات الضخمة والتفاعل الآني، ما يجعل من الثقافة نتاجًا حسابيًا بقدر ما هي رمزية. يعني ذلك أن الثقافة الرقمية أصبحت تُنتج وتُفهم بناءً على أنماط التفاعل والبيانات، لا فقط بناءً على المعايير الجمالية أو الرمزية السابقة، وهو تحول يهدّد بخسارة البُعد التأويلي العميق لصالح المقاييس الكمية مثل الإعجابات والمشاهدات.
وهكذا، فقد تراجعت هيمنة المؤسسات الثقافية التقليدية لصالح المنصّات الرقمية التي أصبحت تقوم مقام الوسيط والناشر والمُنظم. وكما بيّن مارشال ماكلوهان (1964)، فإن “الوسيط هو الرسالة”، أي أن شكل الوسيط يؤثر في مضمون الرسالة. هذه الفكرة تتعزّز اليوم مع ما تطرحه جوزيه فان ديك (2013) التي ترى أن المنصّات الرقمية الكبرى (مثل يوتيوب، وفايسبوك، وتيكتوك) ليست مجرد أدوات للنشر، بل أصبحت بنى تحتية ثقافية جديدة تتحكم في منطق الظهور والانتشار، عبر خوارزميات مبرمجة على أساس الأداء التجاري أكثر من العمق الثقافي.
من جهة أخرى، تتيح الوسائط الرقمية إمكانات للتعبير الفردي والجماعي، ما يشكّل ظاهريًا ما يُعرف بـ«ديموقراطية التعبير الثقافي”. غير أن هذا الانفتاح يحمل مفارقة خطيرة، كما أشار ستيوارت هول (1997)، حيث إن إعادة تمثيل الثقافة يخضع لصراع رمزي بين القوى المُنتجة للمعنى. وهذا ما نلاحظه اليوم في تحكم الخوارزميات في تمثيل الثقافة، كما تؤكد تاينا بوخر (2018) في نظرية “الوسيط الخوارزمي”، حيث يُبرمج الظهور الثقافي وفق منطق الإعجابات والتفاعل، ويتم إقصاء المحتوى الذي لا يحقق الأداء المطلوب، بغض النظر عن قيمته الرمزية أو المعرفية.
إضافة إلى ذلك، يُشير باحثون معاصرون مثل دافيد بيري إلى بروز مفهوم “البيانات الثقافية الكبرى” (Cultural Big Data)، حيث يُنظر إلى الثقافة كمورد رقمي قابل للاستخراج والتحليل والتوظيف، وهو ما يُعيد صياغة دور الإعلام الثقافي ضمن منطق الاقتصاد الرقمي للانتباه بدلًا من المنطق المعرفي أو الجمالي التقليدي.
تحدّيات وآفاق في ظل البيئة الرقمية
لعلّ أحد أبرز التحدّيات التي تواجه الإعلام الثقافي في البيئة الرقمية هو هيمنة السطحية وتسليع الثقافة. فالخوارزميات تفضل المحتوى القابل للمشاركة السريعة على حساب العمق. وتُبرز دراسات معاصرة مثل ما جاء في أعمال “فان ديك” و«زوبوف” أن المنصّات لا تسوق الثقافة بمعناها التنويري، بل تستخدمها كمادة خام لجذب الانتباه وتحقيق الربح. ويضاف إلى ذلك خطر التمثيلات الزائفة أو المُجتزّأة للهوية الثقافية، خاصة في السياقات العالمية، ما يؤدي إلى فقدان المعنى المحلي.
كما يشكل التوليد الآلي للمحتوى عبر الذكاء الاصطناعي تحديًا نوعيًا جديدًا، حيث يمكن “إنتاج” أعمال ثقافية زائفة، تفتقر إلى المرجعية والسياق، ما يُهدّد بتجريد الثقافة من أساسها الإنساني والتاريخي.
في المقابل، ورغم التحدّيات، فإن الوسائط التكنولوجية الحديثة تُتيح فرصًا نوعية لتجديد الفعل الثقافي. من ذلك مثلًا رقمنة التراث، وتقديم الفنون في فضاءات تفاعلية (كالواقع الافتراضي والمعزّز)، وتطوير المتاحف الرقمية، وهو ما من شأنه تقريب الثقافة من فئات مجتمعية جديدة.
وكما رأينا، تُظهر أطروحات مانوفيتش وفان ديك أن هذه الإمكانيات تصبح فعالة إذا أُدمجت ضمن رؤية نقدية ثقافية واعية، قادرة على موازنة الإبداع التكنولوجي مع القيم الرمزية والمعرفية الأصيلة.
وفي هذا الإطار، يصبح من الضروري تطوير سياسات إعلامية وثقافية جديدة، تعيد الاعتبار للبعد التربوي والمعرفي للإعلام الثقافي، بدلًا من تركه أسيرًا لسلطة الخوارزميات وهيمنتها.
أيّ مستقبل للإعلام الثقافي في عصر الذكاء الاصطناعي؟!
في خضم الثورة الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي، يواجه الإعلام الثقافي تحدّيات وفرصًا غير مسبوقة، ليس فقط من حيث الأدوات المستخدمة، بل أيضًا من حيث مضمونه وأدواره ووظيفته داخل المشهد الإعلامي العام. فالذكاء الاصطناعي بات قادرًا اليوم على توليد مقالات ثقافية، تلخيص الكتب، تحليل الاتجاهات الفنية، بل وحتى محاكاة الأساليب النقدية لبعض كبار النقاد. ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول قدرة الصحفي الثقافي على البقاء فاعلًا أساسيًا في هذه المعادلة الجديدة، أم أنه سيُستبدل تدريجيًا بخوارزميات قادرة على إنتاج محتوى ثقافي فعّال وذكي وسريع.
واقع الأمر أن الذكاء الاصطناعي لا يُقصي الصحافة الثقافية بقدر ما يُعيد تشكيلها: فالمهام الصحفية التقليدية، على غرار تغطية الفعاليات الثقافية، وإعداد الروبورتاجات، ومراجعة الأعمال الفنية، يمكن أن تُدعّم اليوم بتقنيات حديثة مثل تحليل المشاعر، الترجمة الآلية، أو استخراج المعلومة من قواعد بيانات ضخمة. غير أن هذه الأدوات تبقى محايدة من الناحية القيمية، ما يُبقي الحاجة ماسّة إلى الصحفي الثقافي بوصفه وسيطًا نقديًا وقيّميًا، يُعيد تأويل الظواهر الثقافية في ضوء سياقاتها الاجتماعية والسياسية، وليس فقط في ضوء “الترند” أو الأداء الرقمي.
من جهة ثانية، تواجه الصحافة الثقافية خطر الانجراف نحو سطحية المحتوى وتجانسه، تحت ضغط الخوارزميات التي تفضّل المقالات السريعة، والعناوين الجذابة، والمضامين البصرية القابلة للمشاركة.. وهذا ما يتطلب إعادة تفكير عميقة في وظيفة الإعلام الثقافي: هل هو مجرد تغطية للأنشطة الفنية والأدبية؟ أم أنه فضاء للنقد الجاد، والوساطة الثقافية، وصيانة الذاكرة الجمعية؟ في هذا السياق، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون مساعدًا، لا بديلًا، إذا ما وُظّف لخدمة سرديات نقدية وتحليلية تتجاوز منطق الكم إلى منطق المعنى.
بمعنى آخر، يبدو مستقبل الإعلام الثقافي في عصر الذكاء الاصطناعي مرهونا بإعادة تعريف دور الصحفي الثقافي، لا كمنتج محتوى فحسب، بل كفاعل معرفي نقدي، قادر على التفاعل مع الأدوات الذكية دون أن يُفرّط في البعد الإنساني والتأويلي للعمل الصحفي. وإذا ما تمّ دمج التكنولوجيا ضمن رؤية تحريرية واضحة ومسؤولة، فإن الذكاء الاصطناعي قد يكون فرصة لتجديد الخطاب الثقافي وتوسيعه، لا لإنهائه.
في الختام، يمكن القول إن الإعلام الثقافي في الزمن الرقمي لم يعد مجرّد قناة لنقل المعاني، بل أصبح مجالًا تُعاد فيه صياغة الثقافة وإنتاجها ضمن منظومات رقمية معقدة. وكما تُظهر المقاربات النظرية المعاصرة، فإن الثقافة لم تعد مستقلة عن أدواتها، بل تشكلها الوسائط، وتعيد تشكيلها المنصّات، وتقيّمها الخوارزميات. وفي ضوء ذلك، يبدو أن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في مواكبة التحوّل التكنولوجي، بل في ضبطه معرفيًا وقيميًا، لضمان أن تظل الثقافة في صميم الإعلام، لا على هامشه.