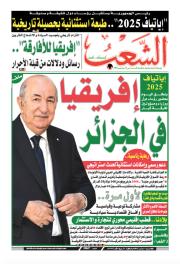تتشكّل ما تُعرف بـ «سياسات الهويّة» من ديناميّة الصراع الفكريّ في سياق التمايز بين هويّتين متناقضتين، حيث لا تنهض أيّ منهما بمعزل عن الأخرى، بل تتحدّد من خلال انعكاس صورتها على كافّة الصعد الاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة والنفسيّة، وهو ما يجعل من هذه السياسات، استراتيجيّة تسعى لإعادة تعريف الذات في مواجهة الآخر، عبر جدل الاعتراف والإنكار، الاكتشاف والمواجهة، وصولًا لمحاولات تطبيق قانون نفي النفي بين الهويّتين المتصارعتين.
هذا التداخل بين الهويّة وانعكاسها في مرآة الآخر، هو ما وظّفه الروائيّ باسم خندقجي لبناء سرديّته «قناع بلون السماء» – دار الآداب- 2023، مستفيدًا من الفلسفة المادّيّة التي استند عليها المجريّ جورج لوكاتش لصياغة «نظرية الانعكاس»، لارتباطها الوثيق بالأدب بوصفه فعاليّة اجتماعيّة وسياسيّة يُمكنها أن تشكّل حقل اشتباك متواصل.
وهو ما عبّر عنه الكاتب على لسان شخصيّته المحوريّة «نور الشهدي» في جدله مع قناعِها/آخَرِها «أور»: «السرّ يكمن بالمرآة..المرآة هي المعادلة، هي التفاصيل...هي الكائنان أحدهما مسيطر والآخر خاضع..أنت أور مسيطر وأنا نور خاضع..ولهذا، يجب أن أحطّم المرآة»، (ص 134).
بهذا المعنى، لم يستخدم الكاتب الأسير القناع كوسيلة تخفٍّ لبطله «نور» في صورته الأخرى «أور»، بل وظّفه كأداة مواجهة قادرة على تحرير الضحيّة من صورتها النمطيّة، لصالح إعادة إنتاجها كمكوّن فاعل يسعى إلى استعادة زمام المبادرة، من دون انفصال عن الشروط التاريخيّة والسياسيّة المهيمنة على كامل المشهد الأرضيّ والسماويّ، كما يُعبّر الراوي البطل عن هذا الواقع قائلًا: «آه..اعذرني لقد نسيت أنّ السجن لا سماء له». (ص 139).
على الرغم من هذا الإقرار، يؤكّد خندقجي في سرديّته، أنّ استعارة القناع تحمل في طيّاتها فعلًا تحرّريًا يكسر المرآة، ويهاجم السرديّة الاستعماريّة من داخل مركزها ذاته، حيث «لم يعد نور يُقيم عند الحافّة، بل في أعماق المركز، مركز آخَرِهِ الذي خلقه من النكبة والأزقّة»، (ص 63).
من هنا، يُمكننا الادّعاء بأنّ باسم لم يكتف بفضح آليّات السيطرة والتحكّم التي أنتجها المركز الاستعماريّ في بلاده، بل سعى إلى قلب المعادلة داخل النصّ وخارجه لمقاومة الاستلاب، إذ جعل من روايته «قناع بلون السماء» مختبرًا سرديًّا تتقاطع فيه إمكانيّات مواجهة الذات كمعطى هويّاتيّ مهمّش، ولكنّه ثابت، مع الحاجة الملحّة لرفض دائرة الانعكاس كقدر يُمكنه أن يُبقي الهويّة رهينة للمرآة؛ ما جعل النصّ يحقّق ما طرحه لوكاتش في نظريّته، من أنّ الأدب لا يكتفي بتصوير الواقع، بل يُسهم في تغييره، وهذا ما أكّده الكاتب بصوت بطله حين قال: «أنا أتجرَّع أكاذيب وأساطير ملعوبًا بأسفل سافلها.. أتجرَّعها ثم ألفظها بمناعتي وحصانتي وعزمي على مواجهة الاغتصاب التاريخيّ الذي نتعرَّض له منذ نكبتنا على الأقلِّ». (ص 26).
بهذا التصريح، يضع الكاتب فعل الكتابة في موقع المقاومة الفاعلة، لا بوصفها مجرّد توثيق للذاكرة أو استعادة للماضي، بل كممارسة واعية لتفكيك الأساطير المؤسّسة للهيمنة الاستعماريّة وإعادة تدويرها؛ إذ لا تكتفي المواجهة السرديّة هنا بإظهار الزيف، بل تسعى إلى إنتاج سرديّة بديلة قادرة على اختراق البنية الرمزيّة التي فرضها المركز، مستندة إلى تفاصيل التاريخ واللّغة كأدوات للردّ.
ولذا، لا يُعدّ «تحطيم المرآة» مجرّد فعل مجازيّ، بل استراتيجيّة نصيّة تعيد إلى الهويّة المهمّشة حقّها في الكلام والفعل، وتحرّرها من أسر الصورة التي رسمها الآخر، لتصبح ذاتًا منتجة للمعنى والتاريخ، لا مجرّد انعكاس لهما، ببساطة لأنّ «الكولونياليَّة تفاصيل صغيرة، إنَّها هوس السيطرة والتفاصيل الصغيرة التي تُشيد في النهاية بنيةً شاملةً متكاملة..تفاصيل معرفيَّة، وتاريخيَّة، وثقافيَّة، ونفسيَّة..لهذا يجب أنْ نحاربها بالتفاصيل ذاتها». (ص 25).
«الكولونياليَّة تفاصيل صغيرة، إنَّها هوس السيطرة والتفاصيل الصغيرة التي تُشيد في النهاية بنيةً شاملةً متكاملة؛ لهذا يجب أنْ نحاربها بالتفاصيل ذاتها».
ما بين المجدليّة وسماء..صراع بقاء وتفكيك
في هذه التفاصيل، لا تقتصر الاستراتيجيّة النصيّة على فعل المجابهة عبر المرآة وانعكاسها فقط، ولكنّها تذهب إلى ما يمكن تعريفه ببناء جسور بين الأديان والعقول المختلفة، لإعادة التفكير في العلاقة بين النقد التاريخيّ والروحانيّ، بغية تطوير أسئلة جديدة حول الهويّة التاريخيّة والدينيّة، مستفيدة من المنهج السجاليّ، لصالح خلاصات نقديّة قادرة على تفنيد تناقضات بعض السرديّات المرتبطة بالتاريخ الاجتماعي لهذه المنطقة ورموزها، كما هي حال شخصيّة «مريم المجدليّة» التي حاول الروائيّ الأمريكيّ دان براون في رواية «شيفرة دافنشي»، «نزعها من سياقها التاريخيّ الجغرافيّ الفلسطينيّ ليلقي بها في مهاوي الغرب»، (ص 24)، على حدّ تعبير نور الشهدي.
غير أنّ خندقجي الذي لجأ إلى تكنيك تسجيل البطاقات الصوتيّة، استطاع أن يوسّع من مساحاته الخاصة أوّلًا، لخلق الحافز الأساس لتبادل أدوار السرد والتفاعل الظاهر والخفيّ بينها، مرّة بصوت السارد باعتباره «الراوي العليم» ومرّات بأصوات شخوصه وعلى رأسهم بطله «نور» وقناعه «أور»؛ وثانيًا لنزع أيّ خلط متعمّد أو محتمل بين ما هو تاريخيّ ودينيّ وتخيّليّ وأيديولوجيّ، من خلال حواره المفتوح مع صديقه الأسير مراد، والذي يمكننا اعتباره المتلقي الشريك والفاعل في صياغة مقولة الرواية ومقاصدها.
وهي الحيلة التي تجعلنا نقرّ ببراعة باسم الروائيّ الأسير، الذي تمكّن من إعادة إنتاج علاقة السيطرة بينه وبين سجّانه على المستوى الشخصيّ، وبينه كممثّل شرعيّ عن الفلسطينيّ ومستعمِره الكولونياليّ على المستوى العام، عبر تخليق سمائه بوصفها فضاءً للحريّة في ظلّ سجن لا يمكن اعتباره إلّا رمزًا لبنية سلطويّة عادة ما تحجب الحقيقة؛ ولنتأمّل في هذا السياق قوله: «كم أحسدك يا مراد على سجنك الأصغر؛ لأنَّ واقعك الحديديّ هذا واضح الملامح مكوَّنٌ من معادلةٍ بسيطة، لكنَّها قاسية: سجن سجين سجَّان». (ص 50).
من خلال هذه الاستراتيجيّة السرديّة المركّبة، يفتح خندقجي الجرح الفلسطينيّ على أسئلته الذاتيّة والموضوعيّة، لا لمساءلة الأحداث بلغة اعتباطيّة أو انفعالية عابرة، ولكن، ليعيد صياغة معنى صمت ولغة بطله نور، المخيم وأسمائه، والسجين وعلاقته بالسجّان، والتصنيف كتجسيد للتهميش، والكرامة، والحريّة، والتحرّر، والقناع، والسماء، والنكبة ومعناها، كما يقول: «من العار أن نحتفل كلّ عام بذكرى النكبة على أنَّها مجرَّد حدث تاريخيّ مضى. النكبة لم تنتهِ بعد..رحِمها ما زال خصبًا وقادرًا على الإنجاب في كلِّ لحظة..إنجاب القتل والتشريد والتطهير العرقيّ والإبعاد والتهجير والمصادرة والتدمير والإقصاء والتهميش والتصنيف والالتباس والسّلام المزيَّف». (ص 120).
ولأنّ «النّكبة يا صديقي هي النصب التذكاريّ للمحرقة» (ص 157)، دفع الكاتب بسرديّته لتصبح مسرحًا لإعادة تمثيل مشهد التفاوض ما بين ضحيّة وجلّاد، وما بين التاريخ ومزوّريه؛ إذ لم يكن هدفه إعادة إخراج الصورة من زاوية أخرى، بل كشف هشاشة جميع الزوايا والحدود بين ما كان وما يمكن أن يكون، ليؤكّد أنّ اللّغة هنا لا تمثّل أداة تمثيل، بل وسيلة لتفكيك السرد السائد، فهي تنقل الحكاية وتعيد ترتيب عناصرها حتى لا يتزعزع اليقين ولا تختلط الأدوار، وحتى تبقى الأسئلة مفتوحة على كافة الاحتمالات. ببساطة لأنهم «وحدهم الذين يموتون لا يمتلكون الحق بالحكي». (ص 132).
ولكي يبقى اليقين متماسكًا والأدوار واضحة، كان لزامًا على باسم خندقجي استدعاء السّماء رمزًا وروحًا، رمزًا يفتح أفقًا جديدًا لفهم العلاقة بين الذاكرة والهويّة، بين سرديّة الغريب، ورواية الأصيل؛ وروحًا لا تهدف إلى محاكاة التاريخ أو ترديد سطوره الزائفة، بل لتفكيك الأساطير التي فرضتها الهيمنة الاستعماريّة، فكانت شخصيّة «سماء إسماعيل» تلك الفتاة التي شكّلت درعًا واقيًا حال دون ذوبان هويّة «نور» في قناعه «أور»، لتغدو جزءًا من الأسئلة المفترضة، وبعضًا من إجاباتها المحتملة، في سياق بحث مستمرّ عن الحقيقة المغيّبة وسط الكثير من ادعاءات التشويش والإنكار.
«لقد امتلكت سماء الجرأة بالقول إنّها متضامنة مع ضحايا المحرقة، ولكن ضمن رؤية إنسانية لا صهيونية، إذ هي ضدّ صهينة الهولوكوست وإحالتها إلى منظومة أخلاقيّة تحمي وتُشرّع التطهير العرقي الذي مورس بحقّنا في نكبة 1948». (ص 225).بهذه الجرأة، وانطلاقًا من إيمان راسخ بأنّ الثورة الفكريّة تبدأ من تحرير المفاهيم من سياقاتها الوظيفيّة، مكّن باسم خندقجي شخوصه من أدواتهم المعرفيّة والقيميّة لرفض الامتثال لسرديّات الزيف المهيمنة، على نحو حوّل السرديّة بأكملها إلى منظومة مشتبكة، قادرة على تطوير ذاتها وتجديد خطابها وسبل ربطه بالأبعاد الأخلاقيّة، بغية مواجهة المعايير المزدوجة، بوصفها إشكاليّة سائدة ومتعمّدة.
القصّة إذًا لا تدور حول موضوع الالتباس في تعريف الهويّة، ولكنّها تعالج «قصّة الوجوه، تصنيف الوجوه في هذه البقعة من الأرض». (ص 173)، حيث يحاول باسم أن يرسّخ هذه المنظومة المشتبكة، التي تعبّر عن فهمه العميق لفكرة أنّ الهويّة لا تُمنح ولا تُستعاد، بل تُنتج في كلّ مرّة من جديد؛ في مواجهة فعل استعماريّ لم يكتف بسرقة الأرض، بل سعى وما يزال يسعى إلى فرض «هويّة بديلة» للشعب الفلسطينيّ المستهدف، بهدف إجباره على أن يرى نفسه بعين المستعمر، لا بعين ذاته؛ ولذا دفع برواية «قناع بلون السماء» ليشتبك مع الهويّة في ذروة التهديد، ومع المكان في لحظة المصادرة.